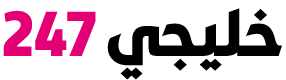ما العولمة؟ يبدو السؤال هاربا من أحد المقررات الدراسية لصفوف الدرجة الإعدادية، سؤال روتيني يحتمل العديد من الإجابات النمطية التي تتحدث عن كيف أصبح العالم قرية صغيرة، وكيف صار التواصل بين الناس أسهل ما يمكن، وكيف أن القميص الذي يُصنع في الهند يُباع في فرنسا ويُلبس في أستراليا بدون مشكلات، وكيف “سقطت” الحواجز بين الناس نهائيا إلى غير رجعة.
لكن هذه النظرة “المدرسية” لكلمة العولمة تبدو مختزلة جدا في الحقيقة، فالعولمة بالنسبة للمفكر المصري عبد الوهاب المسيري، على سبيل المثال لا الحصر، ليست مجرد أداة للتواصل الفعال بين الدول والشعوب، بل هي الطريقة التي تَمكَّن من خلاها الغرب، بزعامة الولايات المتحدة الأميركية، من فرض نموذج بعينه على العالم بأسره، ووفق هذه النظرة فإن العولمة خلقت عالما ينظر إلى الحياة من بُعد واحد فقط.
وحتى على المستوى الاقتصادي، فإن العولمة ليست مجرد تعبير عن اقتصاد السوق الحر، لكنها تطوي بين جنباتها رؤية مادية ترى الإنسان كائنا مستهلكا بالأساس.
وفي الخلف من كل ذلك، تقتات العولمة أساسا على تفكيك الهويات الدينية والقومية والثقافية لصالح نوع واحد من الإنسان، ذلك “الإنسان العالمي المستهلك” الذي لا ينتمي إلى أي شيء سوى محاولة إعادة إنتاج النمط الغربي في نفسه وفي مجتمعه.
وضعت العولمة أسس الهيمنة الأميركية على العالم، وشيَّدت جدرانها وأقامت أسقفها، حتى إذا أخذت تلك الهيمنة زخرفها وزينتها أتتها الشكوك والتساؤلات من جديد، والمفارقة أن تلك الشكوك جاءت من قلب الولايات المتحدة ذاتها، وعلى يد رجل يبدو أنه جاء ليهدم المفاهيم الكلاسيكية للهيمنة الغربية، رافعا شعارا براقا خادعا: “أميركا أولا”.
ترامب.. وإن كان الأخير زمانه
عادة ما يُلقي الرؤساء في العالم، وفي الولايات المتحدة الأميركية على الأخص، عشرات الخطابات في مسيرتهم الرئاسية، بيد أن قلة من هذه الخطابات بقيت خالدة في التاريخ وفي صفحات السياسة، ونحن نعتقد أن واحدا من بين تلك الخطابات التي ستظل تُذكر لفترة طويلة هو خطاب دونالد ترامب يوم الأربعاء 2 أبريل/نيسان بحديقة الورود بالبيت الأبيض في واشنطن، ذلك اليوم الذي وصفه الرئيس الأميركي بـ”يوم تحرير أميركا”.
افتُتح الخطاب بالإشارة إلى “الحالة الكارثية” التي تعيشها الأمة الأميركية حسب ما ترى الإدارة الأميركية الجديدة، حيث المدن والبلدات التي “اغتُصبت” والمصانع التي “دُمرت” أو “نهبت” النتيجة النهائية لذلك، وهو “بلد ممزق تماما”.
والحقيقة أن مَن يتابع خطابات الرئيس الأميركي يعلم جليا أن هذا النوع من المصطلحات والأوصاف ليس بعيدا أبدا عما ألِفَ الناس سماعه منه منذ فترة رئاسته الأولى.
الجديد هذه المرة كان مشهدا لا يكاد أحد يذكر تكرره في السياسة الأميركية من قبل، حين قام ترامب بدعوة صديقه في لعبة الغولف الملياردير هاوارد لوتنيك الذي يشغل منصب وزير التجارة، وقد خرج إلى المنصة حاملا قائمة طويلة للعديد من دول العالم في الشرق والغرب والرسوم الجمركية التي يريد ترامب أن يفرضها على تلك الدول، قبل أن يبدأ ترامب في قراءة الأرقام وكأنه “بائع في مزاد”، وفق وصف “سوزان غلاسر” في مجلة “نيويوركر”.
وقتها فقط ظهرت الرسوم السرية إلى العلن، وبدأت الدول تبحث عن مواقعها في اللائحة مثل طالب يبحث عن اسمه في لائحة التلاميذ الناجحين أو المقبولين، لكن ذلك كان إيذانا ببدء الحرب التجارية الحقيقية التي هدَّد بها ترامب منذ فترة طويلة.
وبمجرد مرور التهديد “الترامبي” إلى الأثير، انتشرت موجات الصدمة في دول العالم، بادئةً بأصدقاء الولايات المتحدة قبل أعدائها. وقبل أن يُنهي ترامب خطابه بدأت ردود الأفعال تتابع بالفعل، حيث بدأت الأسواق المالية حول العالم في الانهيار تباعا مثل أحجار الدومينو، وانخفض الدولار مقابل العملات الأخرى، وسجَّلت الأسهم الأميركية انخفاضا هو الأكبر منذ الأيام الأولى لانتشار جائحة “كوفيد-19″، حيث قُدِّرت الخسائر الأولية بنحو 3 تريليونات دولار.
ولأن رأس المال لا ينظر إلى العامل البشري إلا بصفته أداة من أدوات الإنتاج، بدأ بعض الشركات في الإعلان عن خطط لتسريح بعض العمال تحسبا لأيام سوداء اقتصادية قادمة، وهو ما جعل الاقتصادي الأميركي لورانس سامرز يقول إنه لم يحدث أن كلفت دقائق معدودة أو أقل من ساعة (في إشارة إلى زمن الخطاب) كل هذا الكم من العمال.
والمشكلة أنه لا أحد تقريبا، ونقصد بلا أحد هنا أهل الاقتصاد وعلى رأسهم رجال وول ستريت، توقع أن يُقْدِم ترامب بهذه السرعة على تنفيذ واحد من أهم “الوعود الخطيرة” التي تعهَّد بها خلال حملته الانتخابية.
في أعقاب هذا القرار، الذي أُعلن تعليقه لاحقا لمدة 90 يوما على جميع الدول باستثناء الصين، ما يخبرنا عن حجم “خطورته”، بدأت التحليلات الاقتصادية تلتقي مع التحليلات النفسية حول شخصية دونالد ترامب، فالرئيس الأميركي -حسبما تشير غلاسر مرة أخرى- اتخذ قرارا بنزعة فردية كاملة لتدمير قرن من العولمة بدم بارد، حيث لا يمكن اختصار هذا القرار في الأبعاد الاقتصادية فقط، بل في نزعة ترامب للسيطرة عبر توقيع أمر تنفيذي يفرض رسوما جديدة، مستعملا بذلك سلطاته الواسعة في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، لذلك فقد بدا سعيدا وهو يقول في كلامه: “إنه لشرف كبير أن أتمكّن أخيرا من القيام بذلك”.
عولمة مريضة
ربما تكون تعريفات ترامب هي الضربة الأكبر والأهم التي تتلقاها العولمة في أهم ميادينها وهو الاقتصاد، لكن الحقيقة أن ذلك المفهوم (ونعني هنا النظام الذي يُمثِّله) كان يعاني بالفعل منذ فترة ليست قصيرة. قبل عام تقريبا، كتب “لاري إيليوت” مقالا في “الغارديان” البريطانية، في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الذي انتهى بجلسة تتحدث عن حالة الاقتصاد العالمي.
قال إيليوت في مقاله إن العام لم يكن سيئا لعدد من الأسباب، منها أن ارتفاع سعر الفائدة لم يدفع الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة نحو الركود، بالإضافة إلى أن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة لم تتسبب في رفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل.
بيد أن العام لم يكن رائعا للأسباب الماضية نفسها تقريبا، شبح التضخم، والحروب في الشرق الأوسط التي تهدد أهم طرق التجارة العالمية، ثم وجود انقسامات كبرى بين الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا ذلك الصراع بين واشنطن وبكين.
بحسب إيليوت، في عالم باتت فيه الفجوة بين الشمال والجنوب تتسع باطّراد، والديمقراطية الليبرالية مهددة بسبب “الأنظمة الاستبدادية”، والكوكب يواصل الاحترار، ظهر جليا أن العولمة لم تمت بعد حتى الآن، وأن النموذج الغربي لا يزال قائما، والدليل على ذلك أن طالبي اللجوء يقدمون إلى الغرب وليس إلى روسيا والصين، ما يعني ببساطة أن النموذج الغربي ما زال حيا يُرزق.
بيد أن العالم منذ صدمة الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بدأ يتبدل بالفعل، ثم جاءت جائحة “كوفيد-19” لتبدأ مرحلة “تفكيك العولمة”، أو “العولمة المحلية” (Glocalization)، حسب ما يُطلق عليها البعض. تُعد هذه “العولمة المحلية” مزيجا بين الانكفاء الذاتي وما بين السوق الحر، فهي تتضمن سلاسل توريد أقصر، وتركيزا أكبر على القدرات التصنيعية الوطنية، كما أنها تعطي مساحة أكبر للحكومات المحلية في الجانب الاقتصادي.
غير أن الحاجز الجمركي الذي أطلقه دونالد ترامب ليطلق رصاصة الرحمة التي تلك المحاولة الأخيرة لإنقاذ العولمة من خلال تقييدها بقيود “محلية”، فالرئيس الأميركي الحالي لديه فكرة مختلفة تماما، وهي أنه يمكن لبلاده أن تكون غنية بالدخول في حرب تجارية عالمية مع أصدقائها وأعدائها على حدٍّ سواء.
تأتي الحمائية الاقتصادية التي ينهجها ترامب لتُشكِّل قطيعة مع السياسات الاقتصادية الدولية لواشنطن في عهد جميع مَن سبقوه، تلك السياسات التي جعلت أميركا قوة عظمى تفخر باقتصاد تبلغ قيمته 30 تريليون دولار هو الأقوى على وجه الأرض.
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وصول ترامب إلى البيت الأبيض في المرة الأولى، بذل الرؤساء الأميركيون جهدا كبيرا لتقليل الحواجز التي قد تعترض التجارة والاستثمار والتمويل، متذرّعين بأهداف هي أقرب للبروباغندا من قبيل “نشر الرخاء في الأراضي البعيدة”.
في تعليقها على هذه الخطوة تقول كارمن راينهارت، كبيرة الاقتصاديين السابقة في البنك الدولي، إن ما أعلن عنه ترامب يُعد لحظة تاريخية، لأنه حتى وإن تراجعت الإدارة الحالية عن كل هذا لتلطيف الأجواء قليلا، فإن هذه الخطوة شكَّلت مسمارا آخر في نعش العولمة، فيما يُصِر ترامب على أن التعريفات الجمركية المرتفعة ستفتح “عصرا ذهبيا” جديدا، حيث ستتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات في البلاد، كما قطع الرئيس الأميركي وعودا على نفسه بأن الأسهم سترتفع، وستُبنى مصانع جديدة هي الأفضل في العالم لتكون بديلا لمصانع أُغلقت سابقا في البلاد.
يَعِدُ ترامب بأن أميركا ستكون مختلفة تماما، وهو محق في ذلك يقينا، لكن هذا الاختلاف ليس إيجابيا بالضرورة، فعلى النقيض من وعود ترامب البراقة، يذكر الاقتصاديون كيف تضاعف حجم الاقتصاد الأميركي بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية حيز التنفيذ عام 1994، ذلك الاتفاق الذي جمع في وقت سابق الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وهو نموذج واحد يخبرنا كيف كانت الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر، وبفارق ضخم عن أي جهة أخرى، من التجارة الدولية المفتوحة.
لا يركز الرئيس الأميركي على ذلك، ويركز في المقابل على صدمة عام 2001، أو “صدمة الصين”، التي حدثت بعد انضمام بكين إلى منظمة التجارة العالمية، حينها فقد 2.4 مليون أميركي وظائفهم بحلول عام 2011، رغم أن التجارة مع الصين سرعان ما أثبتت أن فوائدها تفوق مثالبها على أصعدة عدة، فكما ذكرت دراسة لجامعة جورج ماسون، فإن ثلاثة أرباع الأميركيين استفادوا من التجارة مع الصين، بيد أن العمال الذين لا يحملون مؤهلات عالية ظلوا الحلقة الأضعف في هذا الانفتاح.
الصين.. العدو حقا؟
حاولت الإدارات الأميركية المختلفة، بداية من عهد بيل كلينتون، التغلب على المشكلة المحلية التي خلقها دخول الصين إلى الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال العمل على إعادة تأهيل العمال المتضررين ببرنامج “مساعدة التكيف مع التجارة”، لكن مشكلات كثيرة من بينها التمويل حالت دون أن يحقق هذا البرنامج النتائج المرجوة.
رغم ذلك، كان الرؤساء الأميركيون ومستشاروهم الاقتصاديون يدركون دائما أن تلك مجرد ضريبة تُخفي خلفها بحرا من الفوائد، والأكثر من ذلك أنهم أدركوا أن “الميكنة”، وليست التجارة، كانت هي السبب الرئيس لخسارة الموظفين لوظائفهم، وأن ما فعلته الاتفاقيات التجارية هو إظهار حِدّة الأزمة ونيل نصيب الأسد من الغضب الشعبي.
ولكن في الوقت الذي تضاعفت فيه أرباح الشركات الأميركية 3 مرات تقريبا بعد الاستفادة من اليد العاملة الرخيصة خارج البلاد، لم يتزحزح دخل الأسرة المتوسطة الأميركية من 1999 وحتى عام 2015.
في الأخير، تحول النظام الاقتصادي الذي أنشأه الأميركيون برعاية منظمة التجارة العالمية إلى وحش يأكل صاحبه بعد أن فشل في التكيف مع الصعود القوي لاقتصاد كبير مثل الصين، تاركا شريحة لا يُستهان بها من الأميركيين ساخطة على التجارة الحرة.
في عام 2008، بدأ الشعور المعادي للتجارة العالمية يصعد أكثر فأكثر، فقد انتقد باراك أوباما وهيلاري كلينتون اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية، في العام نفسه، وبسبب الأزمة العالمية الكبرى، بدأت مشاعر عدم الارتياح تشمل الصين بالتبعية.
وعندما ترشح دونالد ترامب للرئاسة عام 2016، فإنه صب جزءا كبيرا من غضبه على التجارة، ودافع عن أفكار حمائية تماما، ورغم أن دونالد ترامب لا يُعد شخصية ذات طابع أيديولوجي ولا يمكن نسبة مواقف راسخة له في معظم القضايا، فإن الحمائية الاقتصادية ومناهضة التجارة الحرة تُعد استثناء من ذلك، وتعود جذور هذه الرؤية حتى إلى خلفيته الدراسية في كلية وارتون، التي أسسها الصناعي جوزيف وارتون، المعروف بمعاداته للتجارة الحرة وتشجيع الاكتفاء الذاتي للدول.
يرى ترامب أن بلاده محتاجة إلى إنتاج المزيد من كل شيء تقريبا داخل حدودها بدلا من شرائه من الآخرين (وخاصة الصين)، حتى لو أسهم ذلك في زيادة التكاليف، لأن زيادة التصنيع المحلي ستقوّي المجتمعات المحلية والدفاع الوطني.
ويقف الرئيس الأميركي تحديدا عند أزمة عام 2008 رافضا تجاوزها، رغم أن الأميركيين أنفسهم عادوا ينظرون إلى التجارة نظرة أكثر إيجابية، فـ81% منهم يعتبرونها فرصة للنمو في مقابل 14% فقط يرونها تهديدا، حسب استطلاع حديث أجراه مختبر غالوب في وقت سابق من العام الحالي.
تراهن الإدارة الأميركية الجديدة على بعض الصناعات من قبيل صناعة السيارات من أجل العودة بسرعة إلى مكانتها بوصفها قوة “صناعية”، إذ تعمل المصانع الأميركية الآن بنسبة 68% فقط من طاقتها، مقارنة بـ88% في 2015 بحسب الاحتياطي الفيدرالي، لكن لسوء حظ المتفائلين من إدارة ترامب، يبدو أن هذا التغيير بعيد جدا عن المتناول، فالسيارة تحتوي في المتوسط على 30 ألف قطعة، نصفها يأتي من الخارج، ما يعني أن هناك حاجة إلى بناء سلاسل توريد محلية كاملة، وهو الأمر الذي سيستغرق سنوات ويتطلب تكاليف باهظة.
سياسيا، بدأت ردود الأفعال الدبلوماسية تظهر قبل النتائج الاقتصادية على قرار ترامب الأخير، فقد أعلن مارك كارني، رئيس الوزراء الكندي، أن بلاده بدأت فعلا في البحث عن شركاء تجاريين جدد، أما أوروبا، التي لم يحبها ترامب يوما ولم تحبه، فقد بدأت هي الأخرى تتفاوض مع الهند لإبرام اتفاق تجاري، في الوقت الذي تعزز الصين علاقتها الاقتصادية مع العديد من دول العالم، بما فيها حلفاء للولايات المتحدة.
في هذا الصدد، يقول جيفري فريدن، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا ومؤلف كتاب “الرأسمالية العالمية”، إن تحول إدارة ترامب نحو الأحادية الاقتصادية “لم يغير النظرة الاقتصادية للدول الأخرى ويدفعها لتبني الحمائية الاقتصادية، فقط تحاول هذه الدول حماية نفسها من واشنطن، ومن النظام الاقتصادي الجديد الذي قد ينشأ من الفوضى، وستلعب فيه أميركا دورا مختلفا تماما”.
نهاية نظام؟
من جانبها، لم تقف الصين مكتوفة الأيدي أمام قرارات ترامب، وأشعلت حرب التعريفات بلا تردد، لتصل الأمور الآن إلى صيغة خطيرة: تعريفات بقيمة 245% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة تقريبا مقابل تعريفات بنسبة 125% على واردات أميركا إلى الصين (أعلنت الصين أنها لن ترفع التعريفات أكثر من ذلك في الوقت الراهن)، وأكثر من ذلك استهدفت واشنطن أيضا المكسيك وفيتنام، الدولتين اللتين اعتمدت عليهما الصين في الالتفاف على الرسوم الجمركية التي فُرضت عليها عام 2018.
تبدو تلك أشبه بلعبة لعضّ الأصابع شعارها: مَن سيصرخ أولا؟ فمن جانبها، ترى أميركا نفسها في موقف مهيمن في اللعبة، باعتبار أن الأميركيين يستهلكون من الصين أكثر مما تستهلك الصين من أميركا، في المقابل ترى بكين أنها مَن تمتلك القوة الصناعية الأكبر، وأن أميركا ستضطر للتراجع في نهاية المطاف، وفي خضم تلك التصورات المتبادلة يُخطئ البلدان في قراءة نِيَّات بعضهما بعضا.
على جانب، يواجه ترامب خصما أكثر استعدادا للحرب التجارية حسب ما يؤكد مارك لانتاني، خبير في الشؤون الصينية في جامعة النرويج القطبية، فبعد وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض عام 2020، لاحظت بكين بأن الإدارة الديمقراطية لم تعدل عن القرارات التي اتخذها ترامب، بل حافظت على معظم الرسوم الجمركية التي فرضها، وهو ما جعل الصينيين يعتبرون أن الوقت قد حان من أجل اتخاذ مسافة أكبر مع الاقتصاد الأميركي لتفادي جميع المفاجآت السيئة، وهو ما حدث مع عودة ترامب للحكم مرة أخرى هذه السنة.
لكن المشكلة التي تواجهها الصين حاليا هي أن الإدارة الأميركية لا تمتلك فعليا أي كوابح. فحتى في زمان إدارة ترامب الأولى، كان هناك أشخاص قادرون على منعها من الخروج عن السيطرة مثل جون كيلي، رئيس موظفي البيت الأبيض، وإتش. آر. ماك ماستر، مستشار الأمن القومي، لكن اليوم الوضع مختلف تماما، لن تستطيع لا الصين “العدو” ولا أوروبا الحليفة من إيجاد صوت مختلف في أوساط “كابينت” ترامب.
تقول بعض التحليلات إن ترامب يريد، أكثر من أي وقت مضى، اتباع إستراتيجية تهدف إلى إقناع الطرف الآخر بأنه قادر على القيام بأي شيء، والذهاب إلى أكثر نقطة مجنونة بعيدة ممكنة لإجباره على تقديم تنازلات.
في المقابل، لا تحب الصين أبدا المشكلات ولا الصراعات الكبرى المؤثرة على الاقتصاد العالمي، فهي دولة تزدهر في الأمن والسلم، لكن يبدو أنها تُقاد مجبرة إلى حرب تجارية غير مسبوقة في ضراوتها.
لكن بكين ليست وحدها التي ستدفع ثمن توجهات وقرارات ترامب، فيبدو أن الرئيس الأميركي يُعادي نظاما سياسيا واقتصاديا أسَّسته أميركا نفسها وحصدت جُلَّ فوائده، نظام يجعلها صاحبة اليد الطولى سياسيا وثقافيا واقتصاديا، بما يعني أن واشنطن في طريقها لهدم البيت الصيني سوف تُخرب بيتها بأيديها أولا، والأهم أنها ستهدم بلا رجعة ذلك النظام الذي كفل لها الهيمنة على العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.