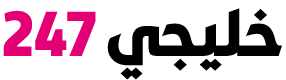تتدفق المروحيات فوق مبنى السفارة الأميركية في مدينة سايغون، عاصمة فيتنام الجنوبية، بينما يتزاحم تحتها آلاف الباحثين عن منفذ خروج من المدينة التي سقطت في يد المقاتلين الشيوعيين من فيتنام الشمالية، في مشهد كان أشبه ما يكون بسباق محموم ضد الزمن والمصير.
لقد كانت تلك اللحظة من صباح 30 أبريل/نيسان 1975، آخر ما يفصل أكبر قوة عسكرية في العالم عن اعتراف صامت وغير معلن، لكنه مدو وصاخب في الوقت نفسه، بالهزيمة في أوضح صورها.
ومع إقلاع المروحية الأميركية الأخيرة مبتعدة عن سايغون بمن أمكنها حملهم، أُسدل الستار على واحدة من أطول الحروب في القرن الـ20، لتنهي الولايات المتحدة صفحة دامية في تاريخها وسط مرارة وانكسار، لم تعرف لهما مثيلا منذ تأسيسها.
ورغم مرور نصف قرن على مشاهد سايغون، لا تزال الحرب الفيتنامية واحدة من أكثر الحروب الحديثة تناولا بالدراسة، ومحور عديد من الأدبيات العسكرية، التي سعت إلى تفكيك أسباب فشل قوة عظمى بحجم الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها السياسية والعسكرية، وإخضاع خصم أقل منها بكثير رغم الفارق الهائل في الإمكانات والموارد ورغم سنوات الحرب الطويلة.
ومع أن الروايات الأميركية فرضت هيمنتها على مجريات التأريخ والتحليل في ما يخص تلك الحرب، فإن ذلك لم يمنع من اعتبارها نموذجا ملهما لحركات التحرر عبر العالم، ودرسا بليغا في كيفية انتصار طرف محدود الموارد على خصم متفوق عسكريا وتقنيا واقتصاديا.
ويعد هذا الدرس مهما بشكل خاص بالنظر إلى حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تخوض فيها المقاومة الفلسطينية والشعب الغزي الأعزل مواجهة ضد الآلة العسكرية الإسرائيلية المتفوقة المدعومة من قبل الولايات المتحدة والقوى الغربية.
لقد طرحت حرب فيتنام سؤالا جوهريا عن سر هزيمة الولايات المتحدة في تلك الحرب، وهي هزيمة ثبت أن أسبابها تتجاوز الأخطاء العسكرية البحتة إلى سوء فهم أميركي متأصل للواقع الذي دارت فيه الحرب وانفصال معرفي جسيم عن الواقع.
لقد خاضت واشنطن حربا على عدو لم تفهمه، في بيئة لا تدرك تعقيداتها، بحسب ما عبرت عنه الصحفية الأميركية الحاصلة على جائزة “بوليتزر” فرانسيس فيتزجرالد، في كتابها “حريق في البحيرة.. الفيتناميون والأميركيون في فيتنام”، حين وصفت مأساة “الغربة المعرفية” الأميركية تلك بقولها: “إن الأميركيين تاهوا بغباء في تاريخ شعب آخر”.
عدّاد الجثث
ولعل أول مظاهر الغياب المعرفي يتجسد في فشل أميركا في استيعاب الطبيعة الخاصة للحرب التي خاضتها، حيث واجه جيشها تمردا مسلحا وحرب عصابات طويلة النفس، استحال خلالها الحسم عبر معركة فاصلة واحدة أو من خلال احتلال عاصمة العدو، وفق الأنماط التي اعتادت عليها الجيوش النظامية.
ومما زاد من تعقيد المهمة أن الفيتناميين نجحوا في المزج بين تكتيكات حرب العصابات والقتال التقليدي المنظم عبر مراحل مدروسة، إلى جانب بذل جهود دبلوماسية، للاستفادة من اضطرابات الجبهة الداخلية الأميركية وانقسامات القوى الكُبرى (استفاد الثوار الفيتناميون من الدعم السوفياتي)، بما أتاح لهم تعظيم مكاسبهم في الميدان والسياسة معا.
في المقابل، وفي مواجهة ضبابية الميدان، لجأت القيادة العسكرية الأميركية إلى سلسلة من التكتيكات والإستراتيجيات التجريبية، لكنها سرعان ما أثبتت قصورها. منها اعتمادها عمليات “البحث والتدمير” الاستنزافية، القائمة على تمشيط الأدغال والقرى واستخدام القوة النارية غير المتماثلة لسحق الخصوم، مع تكثيف القصف الجوي لقطع خطوط الإمداد القادمة من الشمال عبر لاوس وكمبوديا.
وبالتوازي مع ذلك، ابتكرت القيادة الأميركية مقياسا إحصائيا غريبا لقياس التقدم العسكري، عُرف بـ”عدّاد الجثث”، استند لفرضية أن تكبيد المقاومة أكبر قدر من الخسائر البشرية سوف يؤدي في النهاية إلى إنهاكها وكسر إرادتها.
وشملت الممارسات الأميركية أيضا تكتيكات الحرب النفسية، مثل إلقاء ملايين المنشورات واستخدام مكبرات الصوت المحمولة جوّا، لبث رسائل التهديد والذعر في صفوف الفيتناميين.
لكن تبقى أكثر ممارسات الحرب النفسية الأميركية إثارة للجدل هي ما عُرف باسم “عملية الأرواح المتجولة” وتضمنت قيام القوات الأميركية ببث تسجيلات لأصوات بشرية مذعورة ومشوهة، تحاكي أصوات أرواح متخيلة، بغرض إثارة الخوف والارتباك في صفوف الفيتناميين وتقويض معنوياتهم، وإجبار مقاتلي “الفيت كونغ” على الفرار مستغلة اعتقادهم في معاناة الأرواح التي لا تُدفن بشكل لائق.
كانت فيتنام حقلا لتلك التجارب الأميركية وغيرها، لكن رغم تنوع الأساليب، فإن الواقع الميداني ظل عصيا على الأميركيين، فعدّاد الجثث، على سبيل المثال، سرعان ما تحوّل إلى فخٍّ قاتل، إذ دفع الوحدات الأميركية إلى السعي المحموم وراء تحقيق أرقام مرتفعة للقتلى بأي طريقة، حتى لو كان ذلك بارتكاب المذابح في صفوف المدنيين، مما عزز من كراهية السكان المحليين للجيش الأميركي وأفقده فُرص التعاون معهم وكسب ولائهم.
ومن جهة أخرى، شجّعت هذه السياسة على المبالغة المتعمدة وتقديم أرقام مضخمة للقتلى من جانب القادة الميدانيين، بهدف إظهار التفوق أمام القيادة العليا، مما أوحى مرارا باقتراب النصر الحاسم، لكن مع كلّ تعبئة جديدة وتعويض لتلك الخسائر البشرية من جانب المقاومة الفيتنامية، كان يبدو أن “عداد الجثث” يرتد بتأثير معنوي سلبي داخل الوحدات الأميركية، في الوقت الذي يزيد فيه من عزيمة الثوار وتصميمهم.
اختبار إرادة لا اختبار أسلحة
وعلى غرار إخفاق الإستراتيجيات البرية، أثبت القصف الجوي الأميركي أيضا فشله في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والعملياتية.
فعلى الرغم من نصف مليون جندي أمريكي أرسلهم الرئيس ليندون جونسون إلى فيتنام، وإسقاط أكثر من 8 ملايين طن من القنابل، بما يتجاوز أضعاف ما استخدم في الحرب العالمية الثانية (أسقط الحلفاء حوالي 2.7 مليون طن من القنابل خلال سنوات الحرب)، فإن ذلك لم ينجح في خنق المقاومة أو قطع خطوط الإمداد الحيوية.
في غضون ذلك، استمر تدفق المقاتلين والعتاد عبر طريق “هو تشي منه” الأسطوري، حتى إن الإحصاءات الأميركية نفسها أقرت بارتفاع عدد المتسللين من الشمال إلى الجنوب، من نحو 35 ألف مقاتل عام 1965 لما يقرب من 90 ألفا عام 1967 لدرجة أن تكلفة تدمير مستودع مؤن واحد صارت باهظة، قياسا بقدرة الفيتناميين على تعويضه سريعا عبر شبكة إمداداتهم الفعالة والمموهة جيدا.
تزامن هذا الفشل ومشكلة تكتيكية أعمق، فمثلما لم تعرف هذه الحرب خطوط إمداد مكشوفة، لم تكن أيضا تحتوي جبهات محددة قابلة للاستهداف، فهي بالأساس حرب عصابات، يظهر خلالها الخصم مثل طيف كي يضرب ثم يختفي، وسط تضاريس يعرفها كراحة يده وبين سكّان بلده وحاضنته الاجتماعية القوية.
وقد أفضى ذلك في الأخير إلى فشل مبدأ “البحث والتدمير”، الذي تبناه الجنرال وليام ويستمورلاند، قائد القوات الأميركية في فيتنام في الفترة 1964-1968، حين اكتشف الأميركيون أن مواقع العدو لا تبقى فارغة بعد انسحابه، إذ سرعان ما يعود إليها الفيتناميون لاستئناف معادلة الكر والفر، وزرع الكمائن والفخاخ الأرضية، قبل الاختفاء مثل الأشباح في الأدغال أو التسلل إلى شبكة الأنفاق السرية، فور استشعار الخطر.
ومع تعاظم الخسائر والإحباط، اضطرت القيادة الأميركية إلى التخلي عن إستراتيجية “البحث والتدمير”، واعتماد مبدأ “التطهير والاحتفاظ” بدلا منها، ويركز هذا المبدأ على تأمين المواقع عوضا عن مطاردة المقاتلين الأشباح، وتزامن ذلك مع تولي الجنرال كريتون أبرامز القيادة الأميركية في فيتنام خلفا لويستمورلاند.
ولا يعني هذا الطابع الشبحي الذي غلب على المواجهات أن المقاومة الفيتنامية افتقدت المبادرة، فوفقا للدراسة العسكرية الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأميركية، امتلكت القوات الفيتنامية المبادرة في 88% من الاشتباكات ضد القوات الأميركية، على مدار أكثر من 10 سنوات هي عمر التدخل العسكري البري لأميركا في فيتنام، مما يعني أن الأميركيين ظلوا في أغلب الأوقات في موقع رد الفعل لا الفعل.
وحتى في الحالات النادرة التي تمكن خلالها الأميركيون من سحب الفيت كونغ إلى مواجهات مكشوفة، لم تكن انتصاراتهم التكتيكية تترجم إلى تقدم إستراتيجي، إذ سرعان ما تعود المقاومة للظهور في مناطق أخرى جديدة، وتجد القوات الأميركية نفسها مضطرة لإعادة احتلال القرى ذاتها مرارا، في دورة عبثية تجسد إحدى القواعد العسكرية البديهية، وهي أن كسب معركة لا يعني بالضرورة كسب الحرب، ورغم وضوح هذه الحقيقة، فإنه يبدو أن واشنطن نسيتها في غمار المستنقع الفيتنامي.
ولم يكن ذلك إلا انعكاسا لتفوق ميداني نوعي للفيت كونغ، الذين امتلكوا سلاحا أمضى من المدفع والبندقية، فهم أبناء هذه الأرض؛ يحفظون دروبها ويملكون القدرة على اختيار زمان المعركة ومكانها، واستغلال ذلك على أتم وجه، بما مكنهم من توجيه ضربات خاطفة ثم التلاشي وسط الأدغال والحقول والقرى. وأمام هذا النمط من الحرب السائلة، وفي مواجهة خصم يتحرك بمثل هذه المرونة، فقدت التكتيكات الأميركية التقليدية فعاليتها، وبدا الجيش الأميركي مثل دب عجوز ثقيل يواجه نمرا شابا سريعا وفتاكا.
ومما عمق تلك الهوة أكثر، الفارق الجوهري في دوافع القتال، فرغم تواضع تسليحهم، الذي لم يتجاوز البنادق الخفيفة والمدفعية المحدودة مع دعم جوي شبه معدوم، خاض الفيتناميون حربا وجودية دفاعا عن وطن موّحد وبرغبة التحرر من الهيمنة الأجنبية، وهي دوافع تُعلي من الإرادة والصبر والقدرة على التضحية، في حين قاتلت أميركا من أجل فرض النفوذ على دولة بعيدة، ضمن إستراتيجية أيديولوجية هي احتواء الشيوعية.
وشاسع هو الفارق بين مقاتل مستعد للموت من أجل وطنه، وجندي أُرسل إلى أرض غريبة، بناء على حسابات سياسية ربما تتجاوز فهمه.
شكّل هذا التباين عاملا حاسما في مسار الحرب، ففي مقابل استعداد الفيتنامي لتحمل أي خسائر من دون أن تهتز عزيمته، كانت عزيمة أميركا ومعنويات شعبها وعزم قياداتها تتآكل مع كل نعش عائد من فيتنام. وتفاقم المأزق الأميركي مع نجاح الفيت كونغ في بناء شبكات دعم شعبي واسعة في الجنوب (الخاضع للولايات المتحدة)، بين المزارعين والقرويين، الذين وفروا الإمدادات والملاذات الآمنة للمقاتلين، وتحوّلوا إلى جزء من شبكة الحرب، بما جعل مهمة التمييز بين المدني والمقاتل شبه مستحيلة بالنسبة للقوات الأميركية.
أنفاق الفيت كونغ.. كابوس تحت الأرض
ولم تقتصر معضلة التعامل عناصر الفيت كونغ على المعارك فوق الأرض، بل امتدت عميقا تحتها، فثمة ميدان قتال آخر فُرض على الأميركيين، وهو الأنفاق، التي لعبت دورا حاسما في تغيير قواعد المواجهة. وقد كانت شبكة الأنفاق أكثر من مجرد ممرات للهرب، حيث تشكّلت كمنظومة أمنية وعسكرية متكاملة مكتفية ذاتيا؛ مكّنت المقاومة الفيتنامية من التخفي والرصد والمناورة، ومن إعادة تنظيم الصفوف ونصب الكمائن، لتشكّل بذلك إحدى أعقد بيئات حرب العصابات في العصر الحديث.
وحسب التقديرات، امتدت شبكة أنفاق الفيت كونغ لقرابة 270 كيلومترا تحت الأرض، وتخللتها غرف قيادة وعمليات ومستشفيات ميدانية، وكذلك مخازن أسلحة ومؤونة، كما احتوت مساكن سرية ومصانع للأسلحة الخفيفة، إلى جانب مصائد للمتسللين ومخارج طوارئ تؤدي إلى الغابات والقرى المجاورة، مما جعل ملاحقة عناصر الفيت كونغ مهمة شبه مستحيلة.
وقُدّر لاحقا، أن بناء هذه الشبكات استغرق أكثر من 20 عاما، بدءا من أربعينيات القرن الماضي، في أثناء مقاومة الفيتناميين للاستعمار الفرنسي، ثم تطوّر بعضها بعد ذلك، ليشكّل هذه المنظومة المتداخلة المتعددة المستويات الممتدة تحت الأرض.
وقد تجلى التأثير العملياتي لشبكة الأنفاق بوضوح في أكثر من مناسبة، منها الهجوم الذي نفذته وحدات الفيت كونغ في فبراير/شباط 1969 على قاعدة “كوتشي”، إحدى أكبر القواعد الأميركية في فيتنام، مما أسفر عن تدمير 9 مروحيات من طراز “شينوك-47” وإلحاق الضرر بـ3 أخرى، فضلا عن تفجير مستودع الذخيرة الرئيسي داخل القاعدة.
والمفارقة أن قيادة القاعدة تلقت تحذيرات استخباراتية مسبقة بشأن الهجوم، ورغم ذلك، فإن نحو 80 من خبراء المتفجرات التابعين للفيت كونغ تمكّنوا من التسلل إلى عمق القاعدة، وإتمام مهمتهم في غضون دقائق معدودة، من دون أن يتمكن الحراس من اكتشافهم، مما دفع بعض الجنرالات الأميركيين لاحقا إلى الاعتراف بأن شبكة الأنفاق تحولت إلى كابوس نفسي يقوض الشعور بالأمان، حتى في الخطوط الخلفية.
ويؤكد هذا التأثير جو بوتشينو، المحلل العسكري ومدير الاتصالات السابق في القيادة المركزية الأميركية، في مقال بمجلة “فورين بوليسي” إذ يشير إلى أن أنفاق فيتنام تجاوزت تأثيرها المادي نحو إحداث ذعر وارتباك نفسي وجنون ارتياب مستمر بين الجنود الأميركيين، لأن العدو القادر على الظهور فجأة من باطن الأرض يحوز ميزة كاسحة، إذ يكسر أي شعور أمان يمنحه التفوق التسليحي.
ورغم المحاولات الأميركية المتكررة لتدمير الأنفاق، عبر القصف الجوي والمدفعي أو الغمر بالمياه والغازات السامة، فإن طريقة بنائها البسيطة والفريدة في الوقت نفسه، بطبقات متعددة من الطين المدكوك هيّأتها للصمود أمام الانفجارات، كما أن تصميمها المرن أتاح للفيتناميين تجاوز المناطق المتضررة ومواصلة القتال دون تأثير يُذكر.
وحسب الكاتب ومؤرخ الحرب الأميركي وليام بي هيد، فقد تشكّلت أنفاق فيتنام من تربة احتوت على الطين والحديد، مما أدى إلى تكوّن عامل ربط يشبه الأسمنت. واعتمد البناء على آلية بسيطة، حيث جرى الحفر في موسم الرياح الموسمية حينما تكون التربة لينة، وعند جفافها لاحقا تبقى مستقرة دون حاجة إلى دعامات.
ويُشار إلى أن اكتشاف الأميركيين لتلك الشبكات لأول مرة كان في أعقاب “عملية اللصوص” (Operation Marauder)، التي نفذها اللواء الأميركي 173 المحمول جوّا بالاشتراك مع الكتيبة الأولى من الفوج الملكي الأسترالي في دلتا نهر ميكونغ، خلال يناير/كانون الثاني 1966. ورغم العثور على بعض مداخل الأنفاق خلال تلك العملية، فإن القوات الأسترالية والأميركية لم تدرك آنذاك الحجم الحقيقي ولا مدى تعقيد المتاهة الكامنة تحت أقدامهم.
هجوم “تيت”.. صدمة نفسية ورهان إستراتيجي
ومع تصاعد قدرات الفيت كونغ على المناورة فوق الأرض وتحتها، جاءت اللحظة التي قرروا فيها نقل الحرب إلى مستوى أعلى، عبر شنّ هجوم مفاجئ شامل، استهدفوا خلاله أكثر من 100 مدينة وقاعدة عسكرية في وقت متزامن.
عُرف ذلك الهجوم الشهير باسم “تيت”، وشكّل نقطة تحول فارقة في تلك الحرب. ففي الساعات الأولى من صباح 30 يناير/كانون الثاني 1968، ومع بدء احتفالات السنة القمرية حسب التقويم الفيتنامي (عيد تيت)، اجتاح مقاتلو الفيت كونغ وزملاؤهم من الجيش الشعبي الفيتنامي عددا من المواقع الحيوية في جنوب فيتنام، بما فيها العاصمة سايغون.
اعتمد الهجوم في تصميمه على عنصر المفاجأة، مستغلا حالة التراخي ومتغاضيا عن فارق القدرة العسكرية، بما يجعله أقرب إلى مقامرة طموحة، لكنه لم يكن قرارا اعتباطيا، نظرا لأن القيادة الفيتنامية أرادت من خلاله تحفيز انتفاضة شعبية جنوبية تطيح بالحكومة الموالية للولايات المتحدة في سايغون، وإحداث صدمة نفسية وسياسية داخل الولايات المتحدة، بما يدفع الرأي العام الأميركي نحو مراجعة دعم استمرار الحرب.
بمعنى أن الهدف من الهجوم لم يكن حسم الصراع على الفور، وإنما تحقيق مكاسب إستراتيجية على مدى أبعد، وقد بُنيت الحسابات الفيتنامية للاستفادة من حالة الارتباك التي أصابت الإستراتيجية الأميركية، بعد سنوات من استنزاف قواتها دون نتائج حاسمة.
وعلى الرغم من أن الفيت كونغ لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالمواقع التي سيطروا عليها في سايغون وهيو ومدن أخرى، فإن الهجوم كشف عن هشاشة حكومة الجنوب، وأدى إلى تآكل ثقة الأميركيين بإمكانية حسم الصراع عبر الحل العسكري وحده، ولم يقلل من ذلك التأثير تكبد الفيتناميين خسائر جسيمة على المستوى البشري، تجاوزت 50 ألف مقاتل وفق بعض التقديرات.
كان وقع الهجوم مدمرا على إدارة الرئيس الأميركي ليندون جونسون، التي كانت تروج لفكرة “الضوء في نهاية النفق”، وفوجئت بمطالبة الجنرالات بتعزيز القوات الأميركية في فيتنام، رغم أن أعدادها تجاوزت نصف مليون جندي في ذلك الوقت، وهو ما وضع الإدارة في موقف حرج أمام الرأي العام، ومما أكد أن الحرب أبعد ما تكون عن نهايتها، وأدى إلى تصاعد المظاهرات وتزايد الضغط على البيت الأبيض، ودفع جونسون إلى إعلان عدم ترشحه لولاية ثانية بعد أسابيع قليلة من الهجوم.
هكذا لم يكن هجوم تيت مجرد معركة عسكرية، بل ضربة نفسية وإستراتيجية زلزلت ركائز المشروع الأميركي في فيتنام، وأطلقت 7 سنوات أخرى من القتال المرير، انتهت بمشهد إقلاع آخر مروحية أميركية بعيدا عن سايغون.
وعلى امتداد السنوات التي تلت سقوط سايغون ونهاية الحرب، كان الاعتقاد يترسخ أكثر فأكثر بأن هجوم “تيت” كان هو بداية النهاية لتلك الحرب، حين كشفت فيتنام عن حدود القوة العسكرية، وأكدت لخصومها أن كسب الحروب لا يتحقق فقط عبر التفوق في العتاد، بل يتطلب فوق ذلك إرادة لا تلين، وفهما أفضل للأرض وللشعوب التي تقاتل دفاعا عن مصيرها ووجودها.