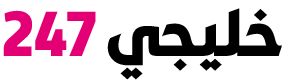عندما صرخ كارل ماركس في خاتمة بيانه الشيوعي: “يا عمّال العالم اتحدوا”، لم تصل الصرخة على ما يبدو إلى مسامع اليسار التونسي، ولم تتردد أبدا في أروقته، فرغم انضوائه تحت العنوان الكبير لليسار، فإن فسيفساءه المتشظية جعلت منه “يسارات” متعددة، فشلت جميعها في انتهاز الفرص التاريخية العديدة لبلورة أفكارها وإحداث التغيير المنشود والمشاركة فيه، أو حتى الوصول إلى موقع مرغوب ضمن ترتيب السلطة في البلاد.
وعقب ثورة الياسمين عام 2011، لم تتحقق آمال اليسار العريضة في استغلال الحالة الثورية التي لطالما انتظرها لتحويل الزخم الجماهيري نحو تحقيق أهدافه. ورغم أن أحد أوائل مَن نادوا بانتخاب مجلس تأسيسي بعد الثورة كان زعيم حزب العمال الشيوعي حينها حمة الهمامي، فإن حزبه حصل على 3 مقاعد فقط من أصل 217، وحصلت جميع الأحزاب اليسارية الأخرى على نحو 11 مقعدا موزعة على 7 أحزاب.
تكررت مرارة تلك اللحظة في فم اليسار التونسي في مناسبات مختلفة، بعضها سبق انتخابات 2011، وبعضها لحقها حتى انتخابات 2019 وما بعدها.
فشأنه شأن العديد من تجارب معسكرات اليسار في دول أخرى، يعيش اليسار التونسي انقسامات فكرية وتنظيمية تتجلى في غياب جسم موحد يجمعه عند المواعيد الانتخابية، وتركيز الجهد على التنظير النخبوي والمعارك الأيديولوجية، أو ما يصفه الباحث وأستاذ علم الاجتماع التونسي المولدي قسومي بحالة “الطّفوليّة السياسيّة”، لكن أزمة اليسار التونسي لديها خصوصيتها أيضا، ولا يمكن فهمها دون النظر للعلاقة مع المحتل الفرنسي السابق.
التنظيم في تونس.. والهوى في فرنسا
نشأ أول مكونات اليسار التونسي مطلع عشرينيات القرن الماضي، أي بعد ثلاث سنوات تقريبا على الثورة البلشفية في روسيا. وبعد أن تنظم الرفاق البلشفيون وأطلقوا على أنفسهم اسم الحزب الشيوعي، أخذوا على عاتقهم قيادة الثورة العالمية أو “إلهام عمّال العالم”، وهو ما لقي استجابة متحمسة خارج حدود روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية، وظهر آنذاك ما يُعرف باسم “الأممية الثالثة” أو “هيئة الأركان العامة للثورة العالمية”.
ووقَّع كلٌّ من قائد الثورة فلاديمير لينين ورفيقه ليون تروتسكي وسبعة ثوريين أجانب مقيمين في موسكو في 24 يناير/كانون الثاني 1919 على رسالة إلى نحو 39 حزبا شيوعيا وثوريا، معظمها في أوروبا، دعوهم فيها إلى حضور “المؤتمر الأول للأممية الشيوعية” بهدف نشر النموذج السوفياتي للديمقراطية البروليتارية، والقطيعة تنظيميا مع الأممية الثانية (الإطار الذي جمع الأحزاب الاشتراكية والعمالية قبل عهد البلاشفة) وتحويل أحزابها المختلفة إلى أفرع للأممية الشيوعية، مع إنشاء هيئة قيادية مركزية في موسكو من شأنها توجيه الحركة الدولية.
ولبلوغ هدفهم، عمل القادة البلاشفة على تشتيت صفوف الأحزاب الاشتراكية الأوروبية وتصفيتها من اليمينيين والوسطيين، وكان ذلك هو مصير الحزب الاشتراكي الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول 1920 حين خرج من صلبه الحزب الشيوعي الفرنسي مختارا الانضمام إلى الأممية الثالثة، ليصبح منذ حينه أحد أهم الأحزاب الشيوعية الرئيسية في أوروبا التي تلتزم إلى حدٍّ كبير بقرارات موسكو والسياسة الخارجية السوفياتية.
ولم تتوقف عمليات “البلشفة” عند الحزب الشيوعي في باريس ونظائره في أوروبا، ولكنها امتدت إلى المستعمرات الأوروبية ومنها تونس، التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي حينها. فالجامعة الاشتراكية التي تأسست عام 1908 في تونس، وتبعت الفرع العمالي الأممي في فرنسا منذ عام 1912، وقع عليها ما وقع على المنظمة الأم في باريس من انقسام، فظهرت أول نواة شيوعية في البلاد عام 1921، وهو التاريخ الذي يُجمع أغلب المؤرخين على أنه لحظة انبعاث أولى الحركات اليسارية الشيوعية في تونس.
كانت التبعية التي اتسمت بها علاقة الشيوعيين التونسيين بنظرائهم في باريس سببا في جعلهم “العجلة الخامسة للاحتلال الفرنسي”، كما يصفهم الصحفي الصافي سعيد، وجعلتهم عُرضة للانقسامات الأخرى التي عرفتها الحركة اليسارية العالمية. فكانوا من ناحية معزولين عن المجتمع التونسي ومنقطعين عن مشكلاته تحت الاحتلال، ومن ناحية أخرى يخوضون معارك فكرية وتنظيمية تدور رحاها خارج الحدود التونسية.
وظلت مواقف الشيوعيين التونسيين متماهية مع التوجه الشيوعي العالمي رغم “تونسة” التنظيم وانفصاله عن الأممية الشيوعية وتأسيس “الحزب الشيوعي بالقطر التونسي” عام 1939. ويقول الكاتب توفيق المديني إن الشيوعيين التونسيين كانوا عمليا يخدمون المصالح الفرنسية في تونس، فانقلابهم على الحزب الدستوري الحر بقيادة عبد العزيز الثعالبي بعد التحالف معه يُعزى إلى رفع الأممية الثالثة شعار “طبقة ضد طبقة”، معتبرة أن الثعالبي لا ينتمي إلى طبقة العمال.
وإلى جانب خضوع أولوياتهم إلى الأجندة السوفياتية والتركيز على محاربة “الفاشية العالمية” بعد صعود هتلر وموسوليني، دعم الشيوعيون التونسيون مشروع بقاء تونس ضمن الاتحاد الفرنسي، الذي كان من المفترض أن يحل بديلا من التنظيم الاستعماري القديم، وهو ما أضعف جهود الحركة الوطنية التونسية في محاربة الاحتلال.
ولم يلقَ الحزب الشيوعي على ضوء ذلك إقبالا شعبيا عليه، وكان أغلب مَن انضموا إليه عمالا فرنسيين وإيطاليين أو يهودا تونسيين بينما عزفت عنه جموع التونسيين، وهو ما دفع الحزب إلى تغيير اسمه مرة أخرى عام 1943 ليصبح “الحزب الشيوعي التونسي”، وينص في قانونه الأساسي بعد الاستقلال عام 1956 على اقتصار الانتماء إلى الحزب على الحاملين للجنسية التونسية دون غيرهم.
وتزامنا مع محاولات الحزب الشيوعي التونسي إيجاد موطئ قدم له في المجتمع المحلي، كان هناك يساريون آخرون من توجهات ومدارس أخرى يعملون على أصعدة مختلفة، بدأ ظهورهم مع التغيرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، واستقلال تونس وعودة عدد من القيادات التونسية الاشتراكية من رحلتهم الدراسية في فرنسا، إلى جانب الانقسامات الجديدة في الخارطة اليسارية حول العالم.
تصدع اليسار العالمي وتبعثر المشهد التونسي
يقول ويلي تومبسون في كتابه “اليسار في التاريخ” إن الأممية لم تكن مجرد أداة الروس لقيادة الشيوعيين في العالم فحسب، بل كانت مساحة للجدل والخلافات العاطفية، سواء بين القيادات والشخصيات القوية أو بين المركز والأفرع.
فقد رأت القيادة أن الأحزاب الفرعية غير منضبطة بالقدر الذي عليه المركز، ولذا يجب “بلشفتها” وإخضاعها لقرارات موسكو، ما خلق مقاومة مضادة من بعض القيادات المحلية، الذين شعروا بالاستياء لخنق قدرتهم على اتخاذ قرارات مستقلة.
وكما كانت الأوضاع متضاربة على “ساحة الأممية الشيوعية”، كانت كذلك في موسكو نفسها، فقد أخذ شق ليون تروتسكي في الصعود، خاصة بعد وفاة مؤسس الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين عام 1922 وتمكُّن جوزيف ستالين من خلافته، ما خلق حالة جديدة واصطفافات مختلفة في خارطة اليسار العالمي.
اصطف تروتسكي إلى جانب استمرارية الثورة العالمية، في مقابل تركيز ستالين على الحفاظ على التجربة السوفياتية، وتوسع الخلاف وصولا إلى طرد تروتسكي من الحزب وترحيله من أراضي الاتحاد، حيث دعا في منفاه إلى تأسيس الأممية الرابعة والتخلص من نظام ستالين والبيروقراطية السوفياتية من أجل استكمال الثورة، حتى اغتياله في المكسيك عام 1940.
ومهّد هذا الصراع لتصدُّع اليسار العالمي بأكمله، وظهور ما يُعرف باليسار الجديد أو “الطريق الثالث” بديلا من اليسار التقليدي والليبرالية الحديثة بداية خمسينيات القرن الماضي، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وهزيمة الفاشية والنازية واندلاع الحرب الباردة، حيث أراد اليسار الجديد التخلص من وصمة “الشيوعية” والتركيز على تعزيز الديمقراطية والحقوق الفردية وحقوق المرأة، وغيرها من المفاهيم التي استفرد بها الليبراليون ووصموا اليسار بسبب نبذها.
ولم تتخلف الساحة اليسارية في تونس كثيرا عن الانشقاقات الدائرة في ساحة اليسار العالمي، وإنْ اتخذت الخلافات أبعادا أخرى. فالصراع بين الرئيس الحبيب بورقيبة والزعيم صالح بن يوسف كان صراعا ذا أبعاد أيديولوجية يسارية، فتبنّي بورقيبة للاشتراكية الفرنسية كان نقطة خلاف محورية مع بن يوسف الذي اعتنق القومية العربية الناصرية، رغم أن كليهما يساريان، في حين كان الحزب الشيوعي التونسي وحيدا في المعارضة بوصفه حزبا قانونيا منظما.
وبعد اغتيال بن يوسف عام 1961، ومحاولة الانقلاب الفاشلة على بورقيبة عام 1962، تأسس في باريس ما يُعرف باسم “مجموعة آفاق” (PERSPECTIVES)، وهو اختصار لـ”تجمُّع الدراسات والعمل الاشتراكي في تونس” الذي جمع شخصيات ماركسية وناصرية وتروتسكية وغيرها نادت بالتعددية الحزبية وحماية الحريات، تزامنا مع تغيير بورقيبة اسم حزبه إلى “الحزب الاشتراكي الدستوري”، وشروعه رفقة آخرين على رأسهم أحمد بن صالح في تطبيق تجربة اشتراكية جديدة باءت بالفشل، واتخذ يساريون آخرون مسارا نقابيا ضمن صفوف الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي حين بدت مجموعة “آفاق” الأكثر تماسكا والأقدر على احتواء التنوعات الفكرية والتنظيمية اليسارية المنقسمة بين السلطة والمعارضة والعمل النقابي، فإن ذلك لم يدم طويلا، فلم يسمح بورقيبة للآفاقيين بالنضوج والوصول إلى قيادة العمل اليساري المعارض وزج بهم في السجون مع أحكام بالسجن تصل إلى 20 عاما، سرعان ما تراجع عنها وأصدر عفوا رئاسيا عن جميع المحكومين عام 1970، لينتج عن ذلك “تفريخ” عدة تنظيمات يسارية جديدة سرعان ما اختلفت مواقفها في قضايا مثل طبيعة علاقات الإنتاج في تونس، وانتماء تونس إلى الأمة العربية الإسلامية والقضية الفلسطينية والصراع بين الصين والاتحاد السوفياتي.
وظهر على إثر ذلك كلٌّ من “العامل التونسي” و”التجمع الماركسي اللينيني” و”المنظمة الماركسية اللينينية و”الحركة الديمقراطية الجماهيرية” و”حزب الشعب الثوري التونسي” وغيرهم، وهو “تفريخ” سيتواصل على مدار العقود المقبلة في فترة بن علي، ثم أكثر بعد ثورة الياسمين عام 2011.
ومما زاد حسابات اليساريين إرباكا ظهور التيار الإسلامي في البلاد بداية السبعينيات، فهو خصم أيديولوجي في آنٍ ورفيق في المحنة أمام آلة القمع البورقيبية في الآن ذاته، فكان من الصعب بناء موقف متماسك أمامه.
عن ذلك يقول المولدي قسومي في ورقة نشرها عن “خارطة اليسار التونسي” إن اليساريين، وعلى رأسهم الحزب الشيوعي، أبدوا تعاطفهم مع قيادات “الاتجاه الإسلامي” أمام المحاكمات التي تعرضوا لها في بداية الثمانينيات، لكنهم في الوقت ذاته كانوا ممتعضين من توظيف الجماعة للإسلام بوصفه “دين الجميع” لخدمة أجندة سياسية، بحسب قوله.
لم يدم هذا التعاطف طويلا، بل كان سببا آخر في مزيد انقسام اليسار التونسي، بين مَن فضَّلوا الانضمام إلى حكومة بن علي بداية التسعينيات من أجل القضاء على الإسلاميين، وبين مَن فضَّلوا معارضة سياساته على نحو مبدئي وإن كلَّفهم ذلك الاصطفاف مع الإسلاميين. فقد عمل محمد الشرفي، وهو أحد مؤسسي حركة “آفاق”، وزيرا للتعليم مدة عقد كامل في حكومة بن علي الأولى، ونفَّذ خلالها سياسته المعروفة باسم “تجفيف المنابع”، التي ترمي إلى القضاء على أي “منبع” للفكر الإسلامي في برامج التعليم أو داخل المجتمع التونسي.
في حين فضَّلت حركة التجديد (الاسم الجديد للحزب الشيوعي التونسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، التي واصل محمد حرمل مهامه أمينا عاما فيها) بقيادة السياسي والجامعي أحمد إبراهيم البقاء في صف المعارضة الشكلية إلى جانب “التجمّع الاشتراكي التقدّمي”، واختارت شخصيات يسارية أخرى معارضة نظام بن علي ودفع ثمن استبداده، منها حمة الهمامي ومية الجريبي وجلبار نقاش وغيرهم، وكان الخيط الفاصل بين هؤلاء هو سياسات النظام تجاه الإسلاميين، التي اختار بعضهم مساندتها، وفضَّل آخرون معارضتها، ليس تعاطفا مع الإسلاميين فحسب، بل وقوفا عند مبدأ مقارعة الاستبداد.
أحزاب في كل مكان.. وانقسام في كل زمان
لم تعرف فترة بن علي كثيرا من المنعطفات السياسية بسبب القبضة الأمنية المُحْكَمة والعدد القليل من الفاعلين السياسيين خارج إطار النظام، وكذلك كانت الخريطة الحزبية والسياسية أقرب إلى الجمود منذ بداية التسعينيات وحتى قيام الثورة التونسية عام 2011، حينها عاد الجميع إلى الساحة التي أصبحت فارغة من هيمنة التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب بن علي، وشهدت تونس غداة الثورة ظهور أكثر من 60 حزبا دفعة واحدة، وصلت بنهاية العقد إلى 216 حزبا، مع المئات من الأحزاب التي رفضت السلطات ترخيصها.
ولم تغب مكونات اليسار عن الانفجار الحزبي في تونس بعد الثورة، فقد كانت مؤهَّلة فكريا وتنظيميا لظهور العديد من الأحزاب التي يدَّعي كلٌّ منها أنه أصدق تمثيلا للفكر اليساري. لذلك فإن محنة اليسار “لم تنتهِ مع قيام الثورة التونسية” كما يقول مولدي قسومي، و”حالة التشظي والتفتت التي آل إليها اليسار بحلول التسعينيات إلى ما بعد الثورة لم تكن دليل تنوع وثراء فكري وأيديولوجي بقدر ما كانت مؤشرات خلاف وقطيعة وعلامة على ضيق صدور النشطاء”.
وانقسم اليسار بادئ ذي بدء بين رافض للمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية التي دعا إليها رئيس الوزراء محمد الغنوشي بعد هروب بن علي، مثل حزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي، وبين قابل للمشاركة فيها، مثل التجمع الاشتراكي التقدمي وزعيمه السابق أحمد نجيب الشابي، وحركة التجديد وغيرها ممن كانوا سابقا ممثلين في برلمان بن علي.

وبحلول موعد انتخابات المجلس التأسيسي بنهاية عام 2011، لم يكن اليسار يتوقع أن تشظيه وإستراتيجياته التواصلية الضعيفة تجاه شعب محافظ بالأساس، خاصة بشعارات مثل “الشيوعية” التي يصر على تصديرها، سيكلفه خسارة الانتخابات وحصوله على لقب “أحزاب صفر فاصلة”، كناية عن النِّسَب التي حصل عليها في تلك الانتخابات، وهو ما دفع أحزاب اليسار إلى الانضواء تحت لواء واحد بعنوان “الجبهة الشعبية لتحقيق أهداف الثورة” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012، أي بعد عام كامل من إعلان نتائج الانتخابات.
وضمَّت الجبهة 11 مكونا يساريا منها: حزب العمال، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحزب الوطنيون الديمقراطيون، وحزب النضال التقدمي، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب البعث بتونس، وحركة الشعب، وغيرها، في حين فضَّلت بعض المكونات اليسارية الأخرى الانضمام إلى حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة، وفضَّل بعضها الآخر ممارسة المعارضة خارج إطار الجبهة.
ولاحقا، انصهرت تلك الأحزاب مجددا مع طيف أوسع من المعارضة ضمن ما سمي “جبهة الإنقاذ” التي ضمت أحزابا ليبرالية ودستورية ممثلة في حزب نداء تونس وآفاق تونس وغيرها، وذلك بعد اغتيال زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد صبيحة 6 فبراير/شباط 2013، وهو التحالف الذي استمر إلى حين انتخابات 2014، التي فاز فيها حزب نداء تونس، وحلَّت حركة النهضة ثانيا، والجبهة الشعبية رابعا.
ويكفي تتبع تحالفات اليسار التونسي منذ قيامه للوقوف على قدر “العشوائية” والغياب الواضح للتنظيم السياسي، فقد نشأ أولا بوصفه فرعا للأممية الشيوعية الفرنسية، ثم تحالف مع الحزب الدستوري المقاوم للاحتلال الفرنسي، ثم انفصل عنه واتهمه بموالاة الفاشية، ثم انقسم مع صعود بورقيبة إلى الحكم حين فضَّل جزء منه الانضمام إلى حكومته، وفضَّل آخرون البقاء في المعارضة، وهو ما تكرر في عهد بن علي حين أسهم بعضهم في تشكيل نظامه للقضاء على الإسلاميين، وتحالف آخرون معهم لتوحيد الجهود المعارضة لبن علي.
ثم تحالف اليسار مرة أخرى مع الليبراليين والدستوريين وأتباع النظام السابق في حزب نداء تونس ضد الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة، تحالف سرعان ما انفض بعد تحالف النداء والنهضة لتشكيل الحكومة عام 2014، ما أعاد الجبهة الشعبية للمعارضة دون تحالفات، وحتى انفصال الجناح اليساري المكون لحزب نداء تونس نفسه، ممثلا في قيادييه محسن مرزوق وبوجمعة الرميلي وغيرهما، ما يرسم صورة أن اليسار التونسي، إلى جانب انقساماته الفكرية والتنظيمية، ينقسم أيضا بين مَن “يهرول” للسلطة ومَن يعجز عن الخروج من دائرة المعارضة.
ويتتبع الكاتب توفيق المديني مسار تكوين الجبهة الشعبية والانقسامات الواضحة عليها منذ تأسيسها في كتاب بعنوان “اليسار التونسي وعولمة الطريق الثالث”، فلم يكن الفرقاء على اتفاق في البداية إلا على ضرورة توحُّدهم وتمثيل “الطريق الثالث” في تونس، لكن أول خلافاتهم كان حول الوصف المناسب لما حصل في 14 يناير/كانون الثاني 2011 “هل كان ثورة أم انتفاضة؟”، وهو خلاف على ما قد يبدو عليه من سطحية، فإنه مفصلي لتعاطي الجبهة مع الأحداث السياسية ورسم سياساتها بناءً على ذلك.
ويضيف المديني القول إن “عمل الجبهة الشعبية منذ تشكُّلها اتسم بالارتباك السياسي والارتجال في المواقف”، مُرجعا السبب إلى بقاء الانقسامات قائمة داخلها، وتحالفها مع نداء تونس ضمن “جبهة الإنقاذ” و”تنطح” زعيم حزب العمال حمة الهمامي لقيادتها واحتكاره اتخاذ القرار داخلها، ما أثار نزعة الزعامات والمصالح الفردية.
ورغم ذلك، صمدت الجبهة الشعبية منذ تأسيسها وخلال فترة حكم النهضة والنداء حتى اقتراب موعد انتخابات 2019 الرئاسية، حين انفض زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين منجي الرحوي عن الجبهة واستقال معه عدد من مكوناتها، ليخوض اليسار الانتخابات مشتتا مرة أخرى بطريقة اختصرها الكاتب وسام حمدي في عنوان: “هوس الرئاسة في تونس.. لماذا تصر أحزاب اليسار على الفشل؟”، وهو ما أكدته نتائج الانتخابات بحصول المنجي الرحوي على نسبة 0.81%، يليه حمة الهمامي بنسبة 0.69%.

وعلى اعتبار أن العائلة اليسارية أوسع من أطياف الجبهة الشعبية المتناحرة، فإن أكثر مَن حصل من المرشحين اليساريين على نسبة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية كان الصافي سعيد بـ7%، محتلا بذلك المركز السادس.
وبعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 الشروع في “إجراءات استثنائية لمواجهة الخطر الداهم”، وإغلاق البرلمان وتجميد نوابه والاستئثار بالسلطات الثلاث، كان رد فعل اليسار التونسي كالمعتاد منقسما في المعضلة ذاتها التي لطالما انقسم بشأنها، وهي الاختيار بين معارضة الاستبداد والتخندق مع الإسلاميين، أم مساندة الاستبداد والتخلص منهم.
ففي حين أعلن زعيم التيار الديمقراطي محمد عبو مساندته إجراءات “25 جويلية” بوصفه أكبر الأحزاب اليسارية، وتبعه زعيم الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنجي الرحوي والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزواي وغيرهم، قرر حمة الهمامي وآخرون معارضة الإجراءات والوقوف ضد عودة الاستبداد.
تتلخص إذن مسيرة اليسار التونسي حتى كتابة هذه الأسطر في أنه لا يتعلم من دروس الماضي، سواء ماضيه الذاتي أو ماضي اليسار العالمي، فإجراءات سعيد كما قال حمة الهمامي “مشابهة لما حدث عام 1987 عندما انقلب زین العابدین بن علي على الحبیب بورقیبة، وكان عدد التونسیین الذین خرجوا للاحتفال ببن علي یفوق مئات المرات عدد مَن خرجوا يوم 25 يوليو/تموز 2021 لمباركة إجراءات قيس سعيد، ويعلم الجميع اليوم الطريقة التي حكم بها بن علي تونس في العقود اللاحقة”.
ويبدو أن قيس سعيد اليوم يسير على خُطى مشابهة، ولا أدل على ذلك من الأحكام الصادرة أخيرا بحق زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ورفاقه، في ظل ارتباك سياسي واضح في التعامل مع حالة الاستبداد التي تنزلق إليها تونس بسرعة.
فهل يعني ذلك موت اليسار في تونس؟ يقول القيادي في حركة النهضة أحمد قعلول إن اليسار لن يموت، “لكن الشروط الموضوعية والأيديولوجية لتوحُّده غير موجودة”، ما يعني أنه لن يكون قريبا من الفاعلية السياسية في المدى المنظور، وهي إجابة دقيقة إذا عرفنا أن اليسار في تونس رغم عجزه عن التنظيم والتنظم السياسي فإنه موجود بقوة في الساحات الثقافية والنقابية وفي مكونات المجتمع المدني، لكنه يظل عاجزا عن ترجمة هذا الوجود سياسيا، تماما كما هو حاله منذ عقود.