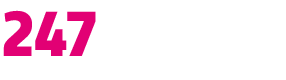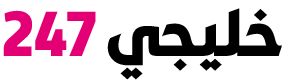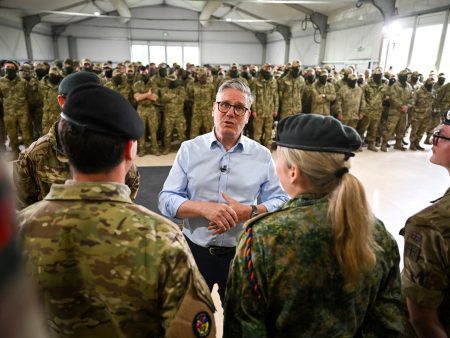يسلط التوتر المستجد بين السلطات الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين الضوء على علاقة متقلبة عمرها قرابة 80 عاما تراوحت بين التحالف الوثيق والمعارضة الشديدة، وصولا إلى قرار الحكومة الأردنية اليوم الأربعاء اعتبار جماعة الإخوان المسلمين جمعية غير شرعية وحظر نشاطاتها في المملكة.
وجاء القرار بعد أيام من إعلان السلطات الأردنية اعتقال 16 شخصا بتهمة التورط في تصنيع صواريخ ومسيّرات بهدف “إثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة”، وسعت الحكومة إلى ربط الموقوفين بالجماعة، في حين نفى الإخوان أي صلة لهم بهذا الموضوع.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم إن الحكومة قررت حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها بعد “اكتشاف مخطط تخريبي مرتبط بأعضاء الجماعة”، في حين ذكر مسؤولون أن القرار اتخذ على أساس الإنفاذ الفوري.
ويمكن للعودة إلى تاريخ العلاقة بين الجانبين أن توفر فهما أفضل لظروف الخلاف بينهما وآفاقه المستقبلية.
البداية الواعدة
تأسست جماعة الإخوان في الأردن في نوفمبر/تشرين الثاني 1945 على يد الشيخ عبد اللطيف أبو قورة الذي التقى قيادة الجماعة في القاهرة وتبنى فكر مؤسسها حسن البنا، وتحمس لدعوته للجهاد ضد الاستيطان اليهودي في فلسطين.
إعلان
سُجلت الجماعة في البداية كجمعية خيرية في يناير/كانون الثاني 1946، وحضر الملك عبد الله الأول الاجتماع التأسيسي للجماعة، مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بينه وبين قيادة الجماعة في ذلك الحين.
وفي عام 1953 رفعت الحكومة وضع الجماعة من جمعية خيرية إلى “جماعة إسلامية متعددة الوظائف”، مما أتاح لها التوسع في أنشطتها وفتح فروع عديدة.
وانخرطت الجماعة في العمل السياسي مبكرا، إذ قدّمت مرشحين عدة إلى البرلمان كمستقلين في عامي 1951 و1954 وترشحت باسمها الصريح في عام 1956.
وجمع التوجه المحافظ اجتماعيا بين قيادات الإخوان والنظام الملكي، وإن كان الإخوان متحفظين على توجه النظام المؤيد للغرب.
وخلال الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي اصطفت الجماعة مع النظام في مواجهة المعارضة القومية واليسارية، والتي رأوا فيها تهديدا، خصوصا بفعل مآلات التجربة القومية في مصر بالنسبة للإخوان ومشروعهم.
وحينما حظرت السلطات الأردنية الأحزاب السياسية عام 1956 لم يتأثر وضع الإخوان بصفتهم جمعية غير حزبية ولعلاقتهم الإيجابية مع الحكم، ووفرت لهم هذه الظروف الفرصة للانتشار وتأسيس المؤسسات، وفي مقدمتها جمعية المركز الإسلامي الخيرية.
النكسة تعزز مشروعية الإخوان
وتشير أستاذة الدراسات الشرق أوسطية في جامعة إيموري الأميركية كاري ويكهام في كتابها “الإخوان المسلمون.. نشوء حركة إسلامية” إلى أن هزيمة العرب في حرب يونيو/حزيران 1967 شكلت ضربة قاتلة للقومية العربية، مما أدى إلى توسع الجماعات الإسلامية في المنطقة.
وفي أعقاب الحرب تعزز العمل الفدائي الفلسطيني من الأردن بمشاركة أعضاء من الإخوان، لكن حينما حصلت الاشتباكات بين الفدائيين والسلطات الأردنية في سبعينيات القرن الماضي بقي الإخوان بمعزل عنها.
إعلان
في المقابل، وسعت الجماعة نشاطاتها في الحياة العامة، وتولى بعض قادتها مناصب حكومية رفيعة، وساهموا في وضع مناهج التعليم الحكومية، وتولى القيادي في الجماعة إسحق الفرحان وزارتي التربية والتعليم والأوقاف عام 1970، وعيّن القيادي عبد اللطيف عربيات أمينا عاما لوزارة التربية والتعليم في الفترة (1982-1985).
وأصبحت الجماعة القوة المهيمنة في اتحادات الطلاب والنقابات المهنية في تلك الفترة، وعندما استؤنفت الحياة البرلمانية عام 1984 بعد توقف دام 14 عاما فاز الإخوان بـ3 مقاعد من أصل 8 كانت شاغرة.
وتزامن ذلك مع بروز تباين في داخل الإخوان بشأن العلاقة مع النظام، وتوترات في العلاقة معه على خلفية الموقف من القضية الفلسطينية، وأصبحت الجماعة أكثر صراحة في معارضتها سياسات النظام، ولكن الطرفين تمكنا من تجنب الصدام.
وامتنعت الجماعة عن تحدي شرعية الملكية، وفي المقابل سمح النظام للجماعة بالعمل العلني والواسع في المساجد والجمعيات الخيرية والخدمية، مما مكنها من بناء قاعدة جماهيرية أهلتها للاستفادة من الانفتاح السياسي في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

ذروة الحضور السياسي
ويشير الباحث ووزير الشباب الأردني الأسبق محمد أبو رمان إلى أن ذروة الحضور السياسي للإخوان كانت عام 1989، فقد أكدت هذه الانتخابات دون أدنى شك الشعبية الجارفة للإسلاميين في البلاد عموما، وللإخوان المسلمين خصوصا.
وحينها خاض الإخوان المسلمون الانتخابات بقائمة موحدة من المرشحين تحت شعار “الإسلام هو الحل”، وتمكنوا من الفوز بـ22 مقعدا من أصل 80 كما حصل عدد من الإسلاميين المستقلين على 4 مقاعد، وقد اعتُبرت النتائج انتصارا إسلاميا كاسحا مقابل الأداء الضعيف للقوميين واليساريين.
وقبيل انتخابات 1989 وقعت ما عُرفت بـ”انتفاضة الجنوب”، وذلك ردا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتعبيرا عن الغضب من قضايا الفساد.
إعلان
وقد أدت هذه الانتفاضة إلى أزمة سياسية وأمنية بين النظام والقبائل الأردنية، وأسفرت عن تراجع وتباطؤ في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كانت الحكومة قد شرعت فيه.
ويشير بعض المحللين إلى أن هذه الأحداث كانت من الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى استئناف الحياة البرلمانية كوسيلة لتنفيس حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي باتت واضحة وخطيرة في نظر القيادة الأردنية.
وفي الوقت ذاته، كان هناك عاملان إضافيان لا يمكن إغفالهما في توليد الزخم نحو استئناف الحياة البرلمانية:
- الأول خارجي: فقد تزامن ذلك مع انهيار الاتحاد السوفياتي وتفكك المعسكر الشيوعي، مما أطلق موجة جديدة من التحولات الديمقراطية على الساحة الدولية، وكان الملك الراحل الحسين بن طلال لا يرغب في تفويت هذه الموجة العالمية.
- الثاني داخلي: ويتمثل في قرار فك الارتباط رسميا مع الضفة الغربية، أي إنهاء الارتباط الإداري بين الضفتين الذي أعلنه الملك الحسين بن طلال عام 1988، وقد أتاح هذا القرار للأردن التحرر من معضلة إجراء الانتخابات في جزء واحد فقط من البلاد دون الآخر، إذ كانت الضفة الغربية تعد حتى ذلك الحين جزءا تشريعيا من المملكة الأردنية.
اتفاقية السلام وافتراق المسارات
تعود بداية الصدع في العلاقة بين الإخوان والنظام إلى أواسط عقد الثمانينيات وفقا لما يراه أبو رمان حين أدركت السلطات أن الجماعة أصبحت قوية بالدرجة التي تجعلها مرشحة لتمثيل المعارضة الرئيسية، وليس اليساريين والقوميين الذين فقدوا الزخم في الشارع الأردني.
ويشار إلى حادثة سبقت الانتخابات البرلمانية عام 1989 شكلت إشارة إلى تحول في العلاقة، وهي الاحتجاجات الطلابية -التي شهدتها جامعة اليرموك الأردنية عام 1985- ضد رفع الرسوم الجامعية بتأثير وحضور من الإخوان، والتي قمعتها قوات الأمن بعنف.
وبلغ الخلاف ذروته مع بداية مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية عام 1991، ويوثق أبو رمان في كتاب مشترك له مع الباحث الأردني حسن أبو هنية بعنوان “الحل الإسلامي في الأردن” هذه المحطة المفصلية في تاريخ العلاقة بين الطرفين، إذ رأت القوى الإسلامية في اتفاقيات السلام مساسا بهوية الدولة، وعبأت الشارع برفض السلام والتطبيع، وأصدرت الفتاوى بحرمة ذلك.
إعلان
وأمام هذا الرفض الإسلامي الصريح تعاملت الدولة مع الموقف بأسلوب مزدوج:
- فمن جهة، تجنبت الدخول في مواجهة دينية أو فقهية مباشرة.
- ومن جهة أخرى، بدأت بتنفيذ إجراءات سياسية وتشريعية تهدف إلى تحجيم نفوذ الإخوان في الحياة العامة.
وكان أبرز هذه الإجراءات إقرار قانون الصوت الواحد عام 1993 الذي وُصف بأنه مفصل لتقليص تمثيل الإخوان في مجلس النواب بعد أن كانوا قد حصلوا على كتلة كبيرة في انتخابات 1989.
كما اتخذت الدولة سلسلة من الخطوات الإدارية والتنظيمية هدفت إلى الحد من تأثير الجماعة في النقابات والجامعات والمساجد، وهي ساحات تقليدية لنفوذها المجتمعي.
ويمكن وصف هذه الإجراءات بأنها جزء من سياسة “إعادة هيكلة العلاقة مع الجماعة”، إذ انتقل الإخوان من موقع “شريك سياسي محتمل” إلى “قوة يجب تحجيمها واحتواؤها” ضمن منظومة أمنية تتعامل مع التهديدات السياسية لا بوصفها اختلافا مشروعا بل تهديدا محتملا للاستقرار والنظام.
وأحرز الإخوان 17 مقعدا في انتخابات عام 1993، وتم التصديق على معاهدة وادي عربة رغم معارضتهم لها مع بعض النواب المستقلين.
ترتيبات ما بعد أوسلو
أبدت الجماعة موقفا واضحا برفض اتفاقيات السلام ومعاهدة وادي عربة، لكنها لم تدخل في مواجهة مباشرة مع النظام، وفضلت التعبير عن اعتراضها من داخل مجلس النواب.
وصوّت نواب الجماعة ضد المعاهدة دون أن يستقيلوا، في محاولة لتسجيل موقف تاريخي، لكن هذا الخيار -كما يشير بعض قادة الجماعة لاحقا- جعلهم يشعرون بأنهم “استُدرجوا” للمشاركة في إضفاء شرعية داخلية على القرار.
ولم تكن هذه التحولات معزولة عن السياق الإقليمي والدولي، فقد جاءت اتفاقية وادي عربة في سياق ترتيبات ما بعد أوسلو، وبدا واضحا أن الضغوط الأميركية والإسرائيلية لعبت دورا في صياغة تصور الدولة الأردنية لمصالحها الأمنية والسياسية، وهو ما انعكس على موقفها من الإسلاميين.
ففي تلك الفترة كانت جماعة الإخوان في الأردن تُتهم بأنها تقدم غطاء سياسيا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي كانت تنشط داخل الأراضي المحتلة وخارجها.
وأصبح الموقف من حماس أحد مؤشرات الاصطفاف الداخلي، وأثّر ذلك بدوره على رؤية الدولة الأردنية لجماعة الإخوان بصفتها “جناحا سياسيا لتنظيم خارجي” قد تتعارض مصالحه مع أولويات الدولة الوطنية.
إعلان
وشهدت تلك الفترة سياسات لتقييد عمل الإخوان في الجامعات والمؤسسات العامة، وهو ما ردت عليه الجماعة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1997، واستمر توتر العلاقة -مع استمرار قنوات الحوار السياسي- إلى حين وفاة الملك حسين عام 1999 وتولي الملك عبد الله الثاني الحكم.

ملك جديد وسياسة جديدة
ويرى أبو رمان في كتابه “الإخوان المسلمون في الانتخابات البرلمانية الأردنية عام 2007” أن الخوف من زعزعة الاستقرار والمخاطر المرتبطة بفترة انتقال السلطة دفع نحو اعتماد مقاربة أمنية مركزة في إدارة الشؤون الداخلية.
وقد أدت هذه المقاربة الأمنية المتشددة إلى نقل ملف الإخوان من كونه مسألة سياسية كانت تدار من قبل الملك شخصيا إلى ملف أمني يُعالَج من قبل جهات رسمية أخرى داخل الدولة.
ونتيجة لذلك، تصاعد التوتر بين الطرفين، وتوقفت قنوات التواصل والاجتماعات والتفاهمات التي كانت قائمة على خلاف نهج النظام السابق.
ووفق أبو رمان، “كان من أبرز التغيرات الإستراتيجية في سياسة الملك الجديد إبعاد قيادة حركة حماس من الأردن عام 1999، وقد مثّل هذا الإجراء مؤشرا واضحا على أن الملك الجديد لا ينوي لعب دور إستراتيجي في شؤون الضفة الغربية المحتلة”.
ويتابع أن “علاقة حماس بالملك الحسين قوية، وكانت الحركة تملك مكتبا سياسيا يعمل علنا ويتمتع بشرعية في الساحة السياسية الأردنية رغم تنفيذ الحركة عمليات عسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأثار قرار الإبعاد أزمة داخل جماعة الإخوان، خاصة بعد اتهام بعض قيادات الجماعة بالصمت على القرار، وبدأت تظهر بوادر انقسام تنظيمي بشأن أولوية “الهم الأردني أو الفلسطيني” وعلاقة الجماعة بحماس، وأدى ذلك إلى صعود تيار داخل الإخوان كان أكثر قربا من حماس، مما أحدث إعادة هيكلة داخلية في الجماعة واستقطابا حول العلاقة مع الدولة ومع حماس نفسها.

تقليص دور الجماعة
توالت محطات التصعيد، إذ حلت الحكومة مجلس النواب في الفترة (2001-2003) وأصدرت في غيابه أكثر من 200 قانون مؤقت عدّتها الجماعة تراجعا في مسار الحياة السياسية وتقييدا للحريات، خصوصا قوانين الاجتماعات العامة والجمعيات.
إعلان
وشهد العام 2004 أزمة على خلفية مشروع قانون لتقييد انشطة النقابات المهنية التي كانت تمثل ساحة نفوذ للإسلاميين، مما دفعهم إلى الانخراط في اعتصامات وإضرابات وصولا إلى تعليق مشروع القانون.
وشكلت تفجيرات فنادق عمّان عام 2005 -والتي تبناها تنظيم القاعدة– ثم فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 دوافع إضافية للنظام لتقليص دور الإخوان.
وأثارت نتائج الانتخابات الفلسطينية مخاوف داخل الدولة الأردنية بشأن “شهية الإخوان للحكم”.
وقبيل موعد زيارة محمود الزهار وزير خارجية الحكومة الفلسطينية التي ترأسها حماس إلى الأردن أعلنت الحكومة الأردنية عن اكتشاف خلية مرتبطة بالحركة كانت تخطط لعمليات داخل البلاد، مما فجّر توترا سياسيا مع جماعة الإخوان التي شككت بالرواية الرسمية، وهو ما اعتبرته الحكومة انحيازا لحماس.
وفي العام 2006 وضعت الحكومة يدها على جمعية المركز الإسلامي الخيرية التي تعد الذراع الاجتماعية للجماعة.
وفي العام 2007 رأى الإخوان في سياسات السلطات وتعديلات قوانين الانتخابات مزيدا من التضييق عليهم، مما دفعهم إلى مقاطعة الانتخابات البلدية ثم المشاركة في الانتخابات النيابية على مضض، والتي منيت فيها بخسارة كبيرة، إذ لم تحصل إلا على 6 مقاعد فقط.
ودفعت هذه التطورات الجماعة إلى تركيز مطالبها حول الإصلاح السياسي في الأردن وتعديل الدستور وتوسيع صلاحيات البرلمان ومكافحة الفساد وتنسيق الجهود مع القوى المعارضة الأخرى، كاليساريين والقوميين.
الربيع العربي
العلاقة بين الطرفين خلال الربيع العربي وما تلاه تناولتها دراسات عدة كدراسة الباحث البريطاني جاكوب أميس، ودراسة الباحثة التركية نيجار كيميكسز، وبناء عليهما تظهر معالم العلاقة في هذه الفترة على النحو التالي:
في السنوات 2011-2013 رفعت الجماعة سقف مطالبها بشكل غير مسبوق، إذ طالبت بتعديلات دستورية تحد من صلاحيات الملك في تشكيل وحل الحكومات، وتعزيز دور مجلس النواب في تشكيل السلطة التنفيذية، وتشكيل مجلس الأعيان بالانتخاب أو بإلغائه.
إعلان
وقادت الجماعة احتجاجات زادت على ألف مظاهرة في العام 2011، ورفضت المشاركة في “إصلاحات شكلية”، ورفضت المشاركة بصفتها المباشرة في لجنة الحوار الوطني.
شكلت الجماعة تحالفا واسعا مع أحزاب قومية ويسارية وقوى عشائرية للمطالبة بالإصلاح، وأصبحت رأس حربة احتجاج يتحدى شرعية النموذج السياسي القائم.

بدوره، أجرى الملك عبد الله الثاني تغييرات متتالية في الحكومات، وأنشأ محكمة دستورية وأجرى تعديلات في قانون الانتخابات، لكن الإخوان الذين رأوا فيها تعديلات محدودة وغير كافية قاطعوا انتخابات البرلمان عام 2013 واستمروا في التظاهر، مع حفاظهم على سلميته وعدم رفع شعار إسقاط النظام.
وكانت نقطة التحول حصول الانقلاب في مصر عام 2013، والذي شكّل صدمة إستراتيجية للجماعة بفعل تحول البيئة الإقليمية لغير صالحها.
بدوره، عمل النظام على ترسيخ الانشقاق الذي كانت بوادره تظهر داخل الجماعة، إذ تم تسجيل جمعية مرخصة تحمل اسم “جمعية الإخوان المسلمين” في العام 2015 بقيادة المراقب العام الأسبق للجماعة عبد المجيد الذنيبات بدعم ضمني من النظام، باعتبارها كيانا قانونيا بديلا عن الجماعة الأصلية.
وفي العام 2020 صدر حكم قضائي بحل الجماعة ونقل ممتلكاتها إلى الجمعية الجديدة، في حين حاولت الجماعة امتصاص الضغوط الرسمية من خلال المشاركة في الانتخابات عبر حزبها المرخص “جبهة العمل الإسلامي”، والتركيز على بعدها المحلي في خطابها وعلاقاتها، لكن تلك الأزمة أفقدتها جزءا من قاعدتها التنظيمية، إضافة إلى الخسارة على صعيد الشرعية القانونية.
طوفان الأقصى وعودة الزخم
وفرت معركة طوفان الأقصى زخما جديدا لجماعة الإخوان في الأردن، وفقا لدراسة لأستاذ العلوم السياسية الأميركي كيرتس رايان، فلم تكن هذه الحرب مجرد حدث خارجي، بل أعادت خلط الأوراق داخليا.
إعلان
فبعد سنوات من التراجع والملاحقة عاد الإخوان وحزبهم جبهة العمل الإسلامي إلى الواجهة من خلال مظاهرات حاشدة وتحركات شعبية ضد العدوان على غزة، وتبنت الجماعة خطابا وحدويا يطالب بإعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل، دون اللجوء إلى العنف.
ويرى كيرتس أن سلوك الإخوان تراوح بين الاحتجاج والتعاون مع النظام في تلك الفترة من خلال التناغم مع انتقادات النظام للحرب.
لكن الاحتجاجات الشعبية -خصوصا ذات الطابع الإسلامي- أحدثت ضغطا على النظام الذي وجد نفسه بين شقي رحى: الحفاظ على معاهداته الإقليمية وامتصاص الغضب الداخلي.
وظهر هذا الأمر جليا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العام 2024، إذ تصدّر حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعبر عن تيار جماعة “الإخوان المسلمين” نتائج الانتخابات، وحصل على نتائج لم يحصل على مثلها منذ الانتخابات البرلمانية عام 1989، وحصل على 31 مقعدا من أصل 138، أي ما نسبته 22.5% من المقاعد، وكان 17 منها من المقاعد المخصصة “للقائمة الوطنية”، أي 44.8% من إجمالي عدد مقاعد هذه الفئة.
وكانت حرب غزة لحظة كاشفة في الداخل الأردني، إذ أظهرت استمرار الفاعلية السياسية للإسلاميين رغم محاولات تهميشهم، وأن القضية الفلسطينية لا تزال نقطة التقاء بين تيارات أيديولوجية مختلفة.
خلاصة
يظهر تاريخ الإخوان والنظام علاقة أقرب إلى التحالف في العقود الأربعة الأولى، ثم تحولا تدريجيا نحو المعارضة بفعل انحسار أثر الأطراف الداخلية المعارضة للنظام، واتجاهه نحو مسار السلام والتطبيع منذ بداية التسعينيات.
وكانت فترات الاضطراب تشهد سلوكا رسميا مؤقتا يهدف إلى احتواء معارضة الإخوان وبقية القوى المعارضة كما حصل في بداية الربيع العربي وبدايات معركة طوفان الأقصى.
وفي المحصلة، عززت المساعي لفرض حل سياسي على قطاع غزة وتحييد المقاومة مساعي تحجيم أي قوى قد تعارض هذا المسار في الإقليم، بما فيها جماعة الإخوان في الأردن، وهو ما قد يفسر تحول سياسة النظام من الاحتواء إلى المواجهة الخشنة مع الجماعة في قضية المجموعات المعتقلة على خلفية دعم المقاومة رغم أن بعضها معتقل لدى الأجهزة الأمنية منذ سنوات.
إعلان