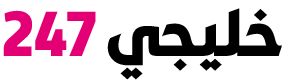تشير بيانات جمعها “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” إلى أن واردات الأسلحة من قبل الدول الأوروبية بين عامي 2020 و2024، زادت بنسبة 155% مقارنة بالسنوات الخمس السابقة. وينظر إلى هذه الزيادات على أنها رد فعل على الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير/شباط 2022.
ولكن من جهة أخرى، تكشف البيانات أيضا عن زيادة مطردة في اعتماد الأوروبيين من بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الشركات الأميركية في تأمين واردات السلاح، إذ زودتهم هذه الأخيرة بنحو 64% من المعدات العسكرية المستوردة، مقارنة بنحو 52% بين عامي 2015 و2019.
ومع وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما تبعه من تحول في سياسة الإدارة الأميركية وفي تحديد أولوياتها، بما في ذلك زيادة الضغوط المشككة في سياسات الدفاع المشترك لحلف الأطلسي، أصبح لزاما على الأوروبيين الاعتماد على أنفسهم أكثر فأكثر في تعزيز دفاعاتهم العسكرية.
لكن السباق الأوروبي نحو إعادة التسلح يصطدم بالكثير من الحواجز، أبرزها أزمة الإنفاق المشترك والمقدر بأكثر من 500 مليار يورو، وتأهيل البنية العسكرية، وتباين حجم المخاطر بين الدول.
مطبات أمام محور باريس برلين لندن
تعتقد المفوضية الأوروبية أن صفقات السلاح المشتركة ستكون أفضل رد لبناء الدفاع الأوروبي. وقد وضع “الكتاب الأبيض” لسياسة الدفاع الصادر عن المفوضية في مارس/آذار الماضي مقاربة لذلك، إذ يرى أنه من أجل إعادة بناء النظام الصناعي الحربي فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يعتمد أولا على السوق الأوروبية في الشراءات العامة التي تشمل القطاعات والتقنيات التكنولوجية ذات الأهمية الإستراتيجية.
وتدفع دول أوروبية مؤثرة داخل التكتل الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا ومن خارجه بريطانيا نحو هذا الحل.
وتقول صحيفة “الغارديان البريطانية” إن أوروبا تغيرت وهي تمر بمرحلة محورية، مما يفسر المشاورات المكثفة بين باريس ولندن وبرلين مع المفوضية الأوروبية من أجل مضاعفة جهودها لتحديد أمنها الجماعي. لكن مطبات كثيرة تعترض جهود هذا المحور.

تعتمد فرنسا على “مظلتها النووية” كرادع أولي في خط الدفاع، وهي مظلة يمكن أن تلعب دورا أبعد من التراب الفرنسي. لكن مع ذلك تواجه خطة الدخول في اقتصاد الحرب خطر الصدام مع المدافعين عن دولة الرفاه الاجتماعي.
بدأ الجدل منذ أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبته في زيادة الإنفاق العسكري إلى ما نسبته 3% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعني ذلك في تقديرات “بوليتيكو أوروبا” ضخ تمويلات إضافية تقدر بنحو 30 مليار يورو سنويا.
لم يطرح ماكرون كيفية توفير هذه التمويلات في ظل استبعاد أي خطط للزيادات الضريبية، وهو ما دفع خبراء إلى إعلان مخاوفهم بشأن إمكانية التضحية بالإنفاق الاجتماعي والدخول في تدابير تقشفية غير شعبية، وتتصاعد التحذيرات من خروج احتجاجات في الشوارع على شاكلة السترات الملونة.
ورغم وجود إجماع داخل البرلمان الفرنسي على ضرورة الرفع من الإنفاق الحربي، فإن الخلاف حول تحديد مصادر تلك السيولة يخاطر بالوصول إلى طريق مسدود.
بعيدا عن الجدل السياسي، تشير تقارير إلى زيادة فعلية في الصناعة العسكرية الفرنسية على الأرض، وهو ما لوحظ خاصة لدى شركة “تاليس”. فخلال 3 سنوات، ضاعفت الشركة قدرتها الإنتاجية 3 مرات وأرسلت شحنات من الطائرات المسيرة والرادارات إلى أوكرانيا.
ويشير إريك مورسو المسؤول عن “إستراتيجية الرادار السطحي” في المؤسسة إلى أن دورة تصنيع الرادار، التي كانت تستغرق 60 يوما قبل عامين، انخفضت إلى 20 يوما.
على عكس فرنسا، تظهر مسألة الأمن في ألمانيا أكثر إثارة للشكوك. اذ يفتقد العملاق الاقتصادي لمظلة نووية ظلت طيلة عقود طويلة من المحرمات السياسية. وفي تقدير الخبراء يجعل هذا الأمر برلين أكثر عرضة إلى الابتزاز الروسي.
تشير خلاصة التقرير السنوي عن حالة القوات المسلحة في البلاد إلى “حالة كارثية” للجيش الألماني المصنف في المرتبة الـ14 عالميا، فرغم ضخ الحكومة ما يقارب مليار يورو في صندوق لتحديث القوات المسلحة منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن التقرير السنوي أشار إلى نقص كبير في المعدات الثقيلة وقطع الغيار والأقمار الاصطناعية والدفاع الجوي واهتراء عدد كبير من الثكنات.
بالإضافة إلى ذلك، تحدثت إيفا هوغل، مفوضة البرلمان للقوات المسلحة، لصحيفة “فيرتشافتس فوخه” الأسبوعية عن نقص كبير في المدربين وعدد الجنود، ومن زيادة معدل السن في صفوف الجيش إلى 34 عاما.
ولا يتعدى عدد الجيش حاليا 181 ألف جندي مقارنة مع 203 آلاف كهدف محدد، ورغم أن عدد المتقدمين زاد في 2024 بسبب إعلانات التجنيد التطوعي فإن الجيش يعاني من زيادة أيضا في عدد المنسحبين.
وطرح للنقاش إمكانية فرض إلزامية التجنيد التي تم التخلي عنها عام 2011. ولكن أكثر المراقبين في ألمانيا يعتبرون هذا الخيار خاطئا من حيث الاستعداد اللوجستي على الأقل، إذ تفتقد الثكنات للمعدات والمدربين لاستقبال أعداد كبيرة من المجندين الشباب على الأمد القريب والمتوسط.
والأهم من ذلك، تأمل الحكومة الألمانية أن يمهد الاستثناء من متطلبات كبح الديون إلى تأمين تمويل الإنفاق الدفاعي في المستقبل.

كان قرارا مفاجئا وفق صحيفة “التايمز” البريطانية، عندما تعهد رئيس الحكومة كير ستارمر في نهاية فبراير/شباط الماضي بزيادة الإنفاق العسكري إلى 2.5% من الناتج المحلي إجمالي بحلول عام 2027، مما يعني إنفاقا إضافيا يقدر بأكثر من 7 مليارات يورو سنويا توجه للقوات المسلحة وتقتطع من “صندوق مساعدات التنمية”.
وفق صحيفة “أونهارد” الإلكترونية، بلغ حجم الإنفاق البريطاني لتمويل المساعدات العسكرية الموجهة لأوكرانيا 12 مليار يورو، مما أدى بالنتيجة إلى تراجع في مخزوناتها العسكرية، ومن ثم فإن الأولوية الآن هي لتوريد الذخائر، وتصميم الطائرات المسيرة، التي يمكن تحريكها بسرعة عند اندلاع نزاع.
وأشارت الصحيفة إلى خطط لزيادة عدد جنود الاحتياط، ولكن من دون توسيع الجيش النشط، الذي انخفض إلى 70 ألف عضو، وهو الأدنى منذ القرن الـ19.
وتعتقد “أونهارد” بأن الاستقلال العسكري التام سيكون مكلفا للغاية بالنسبة لبريطانيا التي تعتمد إلى حد كبير على الولايات المتحدة، وخاصةً في الردع النووي، حيث تستأجر البلاد صواريخها من واشنطن، مما يمنعها من القيام بالدور الذي ترغب به.
وبحسب بيانات “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام”، هناك بالفعل ما يربو على 10 آلاف جندي أميركي في بريطانيا مقابل قرابة 35 ألفا في ألمانيا وأكثر من 12 ألفا في ايطاليا، من بين حوالي 65 ألفا منتشرين في أوروبا.
هواجس الماضي في شرق أوروبا
عادت هواجس الماضي تهب على شرق أوروبا من جديد، حيث تتشارك دول البلطيق مع بولندا ودول إسكندنافية مثل السويد وفنلندا المخاوف ذاتها من عودة المارد الروسي.
تدرك هذه الدول أن أي تحرك عسكري ضدها قد يضعها مجددا مواقف مشابهة لما حدث في الماضي في دانزينغ في عام 1939، أو بودابست في عام 1956، أو براغ في عام 1968، حيث تركت تواجه مصيرها بمفردها.
تعمل هذه الدول وغيرها في شرق القارة على تعزيز مواردها العسكرية بسرعة.
قدمت الرئاسة البولندية مشروع قانون لرفع الإنفاق العسكري إلى نسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي في الدستور، وتأمل الحكومة الوصول إلى نسبة 4.7% بنهاية العام الجاري.
ومن جهة أخرى، تملك بولندا جيشا قوامه 200 ألف جندي محترف، وهو الأول على مستوى الاتحاد الأوربي مع فرنسا والثالث بين دول حلف شمال الأطلسي. ويأمل رئيس الوزراء دونالد توسك أن يبلغ العدد الإجمالي نصف مليون جندي باحتساب جيش الاحتياط.
بالإضافة إلى ذلك، تريد وارسو الاستفادة من المظلة النووية الفرنسية لضمان الردع ضد أي هجوم محتمل، لكن بوضع أكثر أريحية مقارنة بالترسانة النووية البريطانية المرتبطة بالولايات المتحدة.
إلى جانب ذلك، اقترح رئيس الوزراء البولندي أن تنسحب وارسو من اتفاقية دبلن بشأن الذخائر العنقودية واتفاقية أوتاوا بشأن الألغام المضادة للأفراد.

هناك اقتناع كامل في دول بحر البلطيق وهي لاتفيا وليتوانيا وإستونيا، أنها المعنية الأولى داخل حلف شمال الأطلسي باختبار المادة الخامسة لمعاهدة الحلف، التي تضمن الدفاع الجماعي في حالة وقوع هجوم، على خلفية التهديد العسكري المتنامي من جانب روسيا بجانب أقليات ناطقة بالروسية مقيمة على أراضيها.
وحتى الآن، تعتمد ليتوانيا بشكل أساسي على وجود القوات الأميركية من أجل الردع عند أي هجوم عسكري. غير أن هذا الوجود في ظل الإدارة الأميركية الحالية لا يعد ضمانة مطلقة.
كانت ليتوانيا ضاعفت بالفعل ميزانية الدفاع لتصل إلى 2.3 مليار يورو، مما يعني 3% من الناتج المحلي الإجمالي. تتطلع الدولة السوفياتية السابقة إلى أن يصل عدد قواتها المسلحة إلى 20 ألفا مع تزويدها بدبابات ليوبارد الألمانية (سيتم تسليمها بحلول نهاية العقد) وأنظمة الصواريخ الأميركية “اتاكامز” و”هيمارس”.
وترى صحيفة “دزينيك” البولندية أن الخطر الأكثر ترجيحا ليس التخلي عن القوات الغربية المنتشرة في دول البلطيق بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بل زعزعة ترامب للوحدة عبر الأطلسي، وقد يدفع هذا روسيا إلى اختبار المادة الخامسة.
دول مترددة
تنطبق هذه الصفة على دول مثل هولندا وإسبانيا. بالنسبة لهولندا، فقد أبدت موافقتها خلال مشاركة رئيس الوزراء ديك شوف في قمة دول الاتحاد في السادس من مارس/آذار الماضي على خطط زيادة الإنفاق العسكري المشترك من أجل إعادة تسليح أوروبا بتمويل يصل إلى 800 مليار يورو.
لكن البرلمان الهولندي أبدى لاحقا تحفظات على تلك الخطط، بما في ذلك 3 أحزاب من بين 4 تشكل الائتلاف الحاكم. وسبب التحفظ هو تجنب الالتزام بقروض مشتركة مع دول الجنوب واحتمالية زيادة الدين الوطني. ودعا البرلمان إلى تبني موقف وسط، وهو الموافقة على خطة التمويل ولكن بشروط صارمة.
أما إسبانيا، فقد تعهدت الحكومة الاشتراكية بزيادة الإنفاق الذي يعد الأضعف بين دول الاتحاد الأوروبي، من 1.28% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن هذا التعهد يصطدم بنقاش داخل الطبقة السياسية، كونه يتعارض مع “السياسة السلمية” التي أرساها رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغاز ثاباتيرو الذي شغل المنصب بين عامي 2004 و2011.
وتقول صحيفة “إلباييس” القريبة من المعسكر الاشتراكي إنه يتعين على رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الآن “إيجاد توازن دقيق بين الالتزامات الأوروبية وحلف شمال الأطلسي، الذي هو مصمم على احترامها، والواقع السياسي” في البلاد.