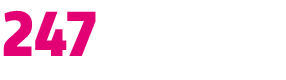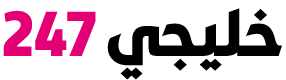هناك إجماع في مختلف المراجع الموسيقية الخاصة بالغناء في الخليج والجزيرة العربية، التي اطلعت عليها، حول ثلاثة أمور: أولها أن فن الصوت نشأ في الكويت وانتقل إلى البحرين في حدود عام 1766، ليزدهر فيهما في منتصف القرن التاسع عشر، وثانيها أن فن الصوت البحريني لئن اشترك مع فن الصوت الكويتي في الكثير من الملامح، إلا أن له طابعه الخاص المختلف بسبب موقع البحرين الجغرافي المتوسط، وتأثره بفنون البلدان القريبة، وثالثها هو أن فن الصوت الخليجي تأثر عموماً لجهة الكلمات والقصائد المستخدمة بما ورد من عدن وحضرموت والحجاز.
أما لجهة تعريف «الصوت»، فهو يُعرّف بأنه قالب غنائي يؤديه الرجال دون النساء، بمصاحبة عازفين منفردين على العود والكمان، علاوة على القانون أحياناً، لكن الآلة الرئيسية والعازف الرئيسي فيه هو «المرواس» و«المروّس». ويتم تأدية الصوت على أوزان محددة تسمى: صوت عربي (ست نبضات)، وصوت شامي (أربع نبضات)، وصوت خيالي (اثنتا عشرة نبضة)، وهذه الأوزان تؤدى على المرواس الذي يُحمل بيد ويُضرب عليه باليد الأخرى، بأسلوب لا يشبه ما هو سائد في الضرب على الطبول العربية.
ومن خصائص فن الصوت الخليجي الأخرى أنه يشتمل على رقص خاص يسمى الزفان، ويصاحبه نوع خاص من التصفيق المتشابك الجماعي، وينتهي بقطعة موسيقية تسمى «التوشيحة» أو ينتهي بتقاسيم مرتجلة، علماً بأن الشعر المستخدم في غناء الصوت عادة ما يكون من الشعر العربي الفصيح الكلاسيكي أو الشعر الحميني.
أما على صعيد المشاهير الأوائل ممن غنوا فن الصوت الخليجي في الكويت فهم عبدالله الفرج، وخالد ويوسف البكر، الأخوان داوود وصالح الكويتي، عبداللطيف الكويتي، محمود الكويتي. وفي البحرين اشتملت قائمة الأوائل على الأخوين عبداللطيف ومحمد بن فارس آل خليفة، ضاحي بن وليد، محمد زويد. وفي عمان سالم راشد الصوري. وفي السعودية عبدالله بوخوة ومحمد علي سندي.
تلك كانت مقدمة ضرورية لفتح نافذة على سيرة ومسيرة أحد رواد غناء فن الصوت في البحرين ممن ارتبط اسمه مبكراً باسم فارس غناء الصوت الأول في البحرين المرحوم «محمد بن فارس آل خليفة» (1895 ــ 1947)، بل عُدّ أحد تلميذيه النجيبين إلى جانب الفنان محمد زويد. والجزئية الأخيرة لئن كانت صحيحة، إلا أن علاقتهما كانت شائكة وملتبسة وصاحبها الكثير من التوترات والصدامات والمناكفات التي أدت إلى قطيعة طويلة بين الرجلين استمرت إلى أواخر حياة ضاحي بن وليد، الذي تُوفي شاباً عازباً عن 45 سنة في عام 1941.
وُلد الفتى الأسمر مجدر الوجه «ضاحي بن وليد» بمدينة المحرق، مهد فنون الغناء الشعبي في البحرين، ومسقط رأس أغلب نجومها، في عام 1896 ابناً لوالدين ينحدران من جذر أفريقي، جيء بهما كخادم وخادمة من مكة المكرمة إلى البحرين في أواخر القرن التاسع عشر، طبقاً لما كتبه حسين المحروس في مجلة «الثقافة الشعبية» البحرينية (العدد 14).
ترعرع ضاحي في المحرق في بيوت أسياد والديه، ولم يتلقَّ أي نوع من التعليم، فظل أميّاً لا يجيد القراءة والكتابة، وهو ما حزّ في نفسه ودفعه إلى البحث عمّا يمنحه هوية خاصة ومسمى جديداً في مجتمعه. وهكذا بدأ حياته ضارباً على آلة الإيقاع المعروفة بالمرواس، والتي يرتكز عليها فن الصوت كما أسلفنا. ويبدو أن ضاحي كان عازماً منذ البداية أن يرافق نجوم الصوت الكبار، كي يبرز وسط مجتمع المحرق الأوسع، ويتحرر من قيود مجتمعه الصغير داخل أسوار مخدومه، فتعلم الترويس جيداً وحفظ شروطه وتقاليده، كما حفظ أغاني الصوت مستخدماً ملكته في الحفظ السريع وعدم النسيان، قبل أن يتسرب إلى دائرة العازفين العاملين بمعية مطرب الصوت الكبير محمد بن فارس، الذي نسب إليه مبارك العماري قوله «مطرب الصوت الحقيقي هو المروّس وليس المغني» (انظر: «إشكالية تدوين تاريخ فن الصوت في الخليج والجزيرة العربية»، مجلة البحرين الثقافية، المجلد الثامن، العدد 27، سنة 2001).
والظاهر أن الفتى ضاحي كان متعجلاً لإثبات ذاته وتفرده كمروّس، بل كان يريد التمرد على محورية دور المطرب في فرض شكل الإيقاع بناء على لحن وقصيدة هو الذي يختارهما مسبقاً، فوقع في المحظور. ولم يكن هذا المحظور سوى عدم التقيد بالإيقاع الرئيسي الذي انتقاه محمد بن فارس ذات يوم، وقيامه بالاجتهاد عبر إدخال زخارف ايقاعية، وهو عمل لم يكن مسموحاً به وقتذاك، وكان يُنعت بالتخريب الذي ينفي عن العمل صفة الصوت.
جملة القول، أن تصرف ضاحي هذا وجرأته في الخروج على المتعارف عليه وعلى محمد بن فارس تحديداً كان مفاجئاً للأخير، ما تسبب في غضب بن فارس عليه وطرده، ووقوع شرخ في علاقتهما. هذا الشرخ الذي اتسع بعد أن نما إلى علم بن فارس أن ضاحي، لا يعمل مروّساً في «دار لخضاري» بالمحرق، وإنما أضاف إلى صفته صفة أخرى هي الغناء، أي أنه صار مغنياً ومؤدياً لفن الصوت بحنجرته، ويحاول مزاحمته. ثم راح الشرخ يتسع أكثر والأمور تتأزم بينهما بعد أن قام ضاحي بتأسيس دار للطرب الشعبي بشمال المحرق في المنطقة المعروفة بـ«لبنان»، وبعد أن راحت الأغاني المسجلة بصوت ضاحي تنتشر في المقاهي الشعبية في المحرق والمنامة.
وعلى هامش خلافات الرجلين، كثرت حكايات المناكفة بينهما التي وصلت حد تصغير بن فارس لاسم ضاحي من باب التقليل من شأنه، فصار يشير إليه في المجالس والدُور باسم «ضحُويْ» بدلاً من ضاحي، كقوله «ضحوي صار مطرب»، و«أشوف ضحوي طلع له صوت». وحينما وصل إلى البحرين من بغداد سنة 1929 مندوبون عن شركة «بيضا فون» لاختيار مطربين من أجل التسجيل لهم في ستوديوهات شركة «هيز ماستر فويس» بالعراق، لم يرشح محمد بن فارس تلميذه ضاحي، ورشح مكانه محمد زويد، بل لم تصدر منه أمام الضيوف أي إشارة إيجابية عنه، علماً بأن شركة «بيضا فون» كانت قد أجرت مسحاً ميدانياً مسبقاً خلصت فيه إلى أن صوتين فقط تنطبق عليهما المواصفات المنشودة في التسجيل (صوت محمد بن فارس وضاحي بن وليد)، طبقاً لعبدالحسين الساعاتي رائد تسجيل الأسطوانات في البحرين. إلى ذلك، أشاع محمد بن فارس ومريدوه أن ضاحي يتنكر ويتسلل للوقوف وراء البرستيات، حيث كانت تعقد جلسات الطرب، كي يتنصت ويتلصص على ألحان محمد بن فارس ونصوص أغانيه من أجل أن يعيد غناءها بصوته. وفي هذا السياق تحدث الباحث الدانماركي والمؤلف في علم الموسيقى «بول روفرينغ أولسون» عن ضاحي في كتابه «الموسيقى في البحرين: الموسيقى التقليدية في الخليج العربي» الصادر في عام 2005 فقال: «يُعرف أنه كان مبتكراً، وفي الوقت نفسه يُشاع بأنه كان سرّاقاً للموسيقى».
مال غصن الذهب
وفي السياق نفسه، أخبرنا مبارك العماري (مصدر سابق) عن أسطورة أخرى من أساطير تلصص ضاحي المزعومة على أستاذه، ومفادها أن أحد الشيوخ من الخليج حضر إلى البحرين لحضور أمسية غنائية لمحمد بن فارس في قرية سنابس، فلم يغنِّ الأخير إلا بعد أن تمّ طرد شخص كان متواجداً، خوفاً من أن يكون جاسوساً لضاحي. ولم يكن هذا الشخص سوى مروّس معروف بقربه من ضاحي اسمه بلال بن فرج.
بعد سنوات من القطيعة بين بن فارس وضاحي بن وليد، وجد الشاعر المحب للغناء الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة (1929 – 2004)، أنه من الضروري وضع حد لتلك القطيعة، فوسّط شخصية كبيرة من وزن الشيخ علي بن عبدالله آل خليفة لإعادة المياه إلى مجاريها بين الفنانين الكبيرين. وبالفعل نجحت الوساطة، والتقيا في الدار المعروفة باسم «السيفية» بقرية الجسرة، طبقاً لحسين المحروس في بحثه المنشور بمجلة «الثقافة الشعبية» (مصدر سابق). وقد روى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وقائع الصلح بين قطبَي فن الصوت البحريني فقال إن محمد بن فارس اشترط قيام ضاحي بن وليد بغناء صوت «مال غصن الذهب» كعربون للصلح، فغناه ضاحي بينما قام بن فارس بالترويس له «إلى حد إدماء أنفه بعد أن استبد به الطرب»، إذ راح بن فارس يقذف المرواس في الهواء ويعود ويتلقفه المرة تلو المرة. وللعلم فإن سبب اختيار بن فارس لصوت «مال غصن الذهب» يعود إلى زمن بدايات ضاحي يوم أن كان مجرد مروّس، إذ فوجئ بن فارس ذات مرة أن ضاحي انتهز فرصة غيابه فأخذ عوده وراح يغني تلك الأغنية تحديداً بصوت خافت، مع إيقاع خفيف، خشية أن ينفضح أمره عند أستاذه.
عودة المياه إلى مجاريها
وهكذا عادت المياه إلى مجاريها بين الأستاذ وتلميذه، لكن بعد أن أصبح التلميذ نداً لمعلمه في الغناء، وبعد أن خرج ذلك الفتى الأسمر المعدم المثقل بتبعات لونه وآثار الجدري وعمله خادماً في بيوت أسياد والديه من أسر وضعه الاجتماعي. غير أن المنيّة سرعان ما وافته. وهنا تتضارب الروايات حول أسباب توقفه عن الغناء في سنوات عمره الأخيرة، ومن ثمّ وفاته. فالبعض يعزوه إلى إصابته بسرطان الحنجرة، والبعض الآخر يعزوه إلى إصابته بالسّل أو السكري، والبعض الثالث يتحدث عن تجرعه للكحول المغشوش، أو الامتناع عن الطعام إحباطاً ويأساً بعد أن أمره مخدومه بالكف عن الغناء (بحسب إحدى الروايات).
نجد في سيرة الراحل أنه سافر إلى بغداد مرتين، الأولى في عام 1932، والثانية في عام 1935، حيث قام إبانهما بتسجيل بعض الأصوات بتنويعات مختلفة وبأسلوبه الخاص مثل أصوات: «سبحانك الله»، و«يارب يا الله»، و«أخو علوي» و«دعوا الوشاة»، و«سألتك أدعوك يا معبود يا فرد»، وغيرها. كما سجل أثناء رحلتيه إلى العراق، بصوته الشجي المتميز شيئاً من «فن العاشوري» مثل أغنية «آه يا سلمان»، علماً بأن العاشوري فن يُستخدم فيه الطبل والطار وتؤديه النساء في الأعراس. أما في رحلته إلى الشام للتسجيل، فقد سجل من فنون الصوت: «يقول أبو مطلق»، و«ألا يا صبا نجد»، و«يقول المولع»، علاوة على رائعة «يا مركب الهند يا بودقلين» من كلمات الشاعر اليمني «يحيى عمر اليافعي»، والتي يُعد ضاحي أول من غناها في الخليج، بصورها العديدة التي تحكي وله راكبي البحر نحو الهند وحنينهم إلى خلّانهم، وبكلماتها الجميلة التي تدل على تجربة الشاعر الشخصية في الأسفار والعشق والاشتياق للمحبوبة. غير أن مبارك عمرو العماري يشير إلى أن أجمل ما غنى ضاحي بن وليد هي أغنية «يا من هواه أعزه وأذلني» من كلمات الإمام سعيد بن أحمد البوسعيدي، بل إن العماري أصدر كتاباً من الشارقة في عام 1922 سماه «يا من هواه أعزه وأذلني: جوهرة الفنان ضاحي بن وليد». كما نجد في سيرة ضاحي أنه، لكي يخرج من جلباب أبيه، عمل لفترة من الزمن نهّاماً على ظهور سفن صيد اللؤلؤ، مستثمراً صوته القوي، فأجاد وانتشر اسمه بين بسطاء الناس والمنحدرين مثله من قاع المجتمع.
وجملة القول، إن قصة صاحبنا هي من أجمل قصص الكفاح في مجال الفن، ومن أجمل صور اختراق الإنسان للقيود الاجتماعية والأعراف المجتمعية التي تكبّله وتقلل من شأنه، بل هي لوحة رسمها فنان موهوب بريشة معاناته فتفجرت غناء سلساً يذيب القلب من كمية الإحساس الصادر من صوته وأسلوبه.
أخبار ذات صلة