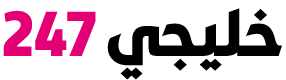عشت في دبلن بين عامي 1999 و 2002 وكانت مكانًا مليئًا بالتناقضات. كانت مدينة متدينة بشكل عميق ولكنها دنيوية بشكل مبالغ فيه، محافظة بتقدير ولكنها ليبرالية بشكل مثير للدهشة، وعنصرية بشكل رهيب ولكنها ودية بشكل مفاجئ. كانت هذه الصورة التي رسمتها لنفسي، كصبي يبلغ من العمر 15 عامًا قادمًا من لندن. كل شيء كان ليس كما يبدو. في المدرسة كان معلمي للغة الإنجليزية أيضًا مدرب فريق كرة السلة. كان رائعًا في كلا المجالين. في الصف، كان يحفزنا على فهم الدقة الشعرية. كان يركز على السطر، يقسمه، ويشجعنا على التفكير في وزنه، إيقاعه، نبرته، بناءه الصرفي، ومساهمته في البيت الشعري بأكمله. في ملعب كرة السلة، كان دقيقًا أيضًا، مشرحًا مفهوم الـ ‘crossover’، كيفية الوقوف، وأين تضع قدميك، متى ترتد الكرة لتوجيه خصمك في الاتجاه الخطأ. كان يطالب بالتميز، في كل مكان، من الجميع. أخذت كل ما استطعت من تعليمه، خلقت عوالمًا في خيالي، وسعت وتدربت حتى في السنة قبل الأخيرة في المدرسة، أصبح عندي ربو ولم أعد أستطيع لعب اللعبة التي أحببتها. لذلك، تركت الملعب وأعطيت ما تبقى من نفسي لصفنا في اللغة الإنجليزية.
كنا ندرس قصائد إليزابيث بيشوب، التي عرفت أنها كانت معاصرة لروبرت لول وماريان مور. كانت أمريكية نشأت في نوفا سكوتيا، وورستر، بوسطن وفلوريدا. كان يمكن أن نسميها طفلًا بثقافة ثالثة – مصطلح يصف الذين نشؤوا في بلدان (وثقافات) أخرى غير بلد الأهل – مثلي. كنا نقرأ قصيدة بيشوب “الخليج”، التي نشرتها في مجلة نيويوركر عام 1949 بعنوان “في عيد ميلادي”. فيه تدرس خليجًا عندما ينخفض مستوى المياه – “الضلوع المتهاوية من الجص”، وشبكة الدجاج، والبجع المتين الذي ينقض في الماء “مثل المطارق، نادرًا ما يأتي بشيء ليظهره”. في نهاية القصيدة، توحي بأن كل هذا – 36 سطرًا من وصف حي لميناء قبيح – يعبر في الواقع عن مكتب كتابتها. السطر “الخليج موزع برسائل قديمة” يرفع القصيدة لتصبح مجرد وصف حرفي ويدخلها في مفهوم واسع ومعقد لحياتها وعملها، كما لو كانت تراجع كل شيء في عيد ميلادها الثامن والثلاثين.
كان يكفي عامين بعد ذلك، أن أخترق في كثافة طفل ثقافة ثالثة، حاول أن يقبل النداء الزائر في داخله، لقراءة كتاب آلان دي بوتون “فن السفر”. في الكتاب، استكشف فكرة أن المسافر يشعر بالقلق عندما يعزل في منظر غير مألوف، وأن هذا العزلة والغرابة يمكن أن تدهشهم ليعكسوا ويقووا اتصالهم بهويتهم الخاصة بطريقة لن تكون ممكنة خلاف ذلك. أنا شاعر وكاتب مسرحي، وأسافر كثيرًا للعمل. في كل مرة أسافر فيها، إذا لم أكن مائجلًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بي، غالبًا ما أجد نفسي أنظر من النافذة لساعات، أفكر في نفسي وتواصلاتي المحتملة مع المناظر الطبيعية التي تمر من خلالها. أحتفظ في ذهني بالأشياء التي أشعر بجذبها وأتساءل لماذا. وهكذا، عندما زرت “لوحات الروح”، معرضًا للفن التشكيلي في جاليري فندلويتش في جنوب لندن والذي افتتح في الربيع الماضي، لعبت هيئتي هذه اللعبة. طافت من غرفة إلى غرفة، مدققة في الأعمال المعروضة، بحثًا عن نفسها باختلافها.
صممتها ليسا أندرسون، “روحية المشاهد” هو مسح كبير يهدف إلى توسيع وإعادة تعريف نوعية الطبيعة. يجمع بين الأشغال الفنية المعاصرة بأنواع مختلفة تتراوح بين الرسم والتصوير والفيلم إلى فن النسيج والكولاج من قبل فنانين مثل هورفين أندرسون، فيبي بوزويل، نجيدكا أكونيلى كروسبي، كيماثي دونكور، آيزاك جوليان، مايكل آرميتاج، مونيكا دي ميراندا وألبرتا ويتل. كلهم من الشريحة الإفريقية المنتشرة حول العالم، وندعى إلى فهم العالم من خلال عيونهم، من خلال مخاوفهم المحددة المتعلقة بالانتماء، الذاكرة، الفرح، التحول. مخاوف تشكلت من تاريخ التحوط المعقد، واستعباد العبودية والهجرة.
لم يكن حتى وقوفي أمام هذه الأعمال الشاملة والباحثة، أفكر في كل ما عرفته، وفكرت باهتمام العلاقة بيني وبين الطبيعة، كان قد ألهمني فنانون وفلاسفة بيض من قبل هذا. لكن حتى ذلك الحين لم أفكر أن إليزابيث بيشوب، آلان دي بوتون والعديد من كتاب آخرين شكلوا تفكيري بعلاقة مختلفة إلى بيئاتهم مما أكون الى الي الآن. بقدر ما كنت أسافر وأقتحم، أتخيل أنهم كانوا قادرين على تحديز الانفس في عالمهم، في طبيعتهم، بطريقة لا أستطيع. أنا مهاجر من الجيل الأول، ولدت في نيجيريا، ونشأت في دبلن ولندن، وبلغت سن الرشد في بيئة بريطانية عنصرية بالغة وسياسة بيئية عدائية والخراف القومية التي شكلت أساس الحوار حول البريكسيت. ويوجد جرح في داخلي. أتت هذه السنوات الصعبة لخلق جرح معين لم أكن مدركًا من قبل. كنت لا أعلم أبدًا أنني لم أتمحور أبدًا في أي منظر طبيعي أوروبي. في عقلي، أنا دائماً خارج المركز، غاءم، مسافراً من خلال الأماكن، لأنني لم أشعر بحالة أمان كافية للبقاء في مكان. لقد بنيت مهنة حول السفر لأنني أشعر بالأمان عندما أكون بحركة. كانت “لوحات الروح” مليئة بصور لناس سود في الهدوء، التأمل، الراحة. جلبت الإدراك المذهل هذا للجرح الذي أحمله – وقدمت شفاءًا ولمحة عن طرق أخرى للوجود، من يمكن أن أصبح، إذا كنت كافيًا شجاعة لتجربتها. في قطعة الحياكة لكيماثي مافافو “رحلة ذاتية نيجتة غير متوقعة”، على سبيل المثال، نرى امرأة سوداء تخرج من شرنقة من القماش الأبيض، تتطلع إلى ميدان طبيعي من زهور وأوراق. في الفيلم “عناكس كيف” لإيزاك جوليان، لقطة من فيلم مصور في كهف جليدي عملاق في آيسلندا، فيه يوجد شخصية سوداء فقط تقف، تتقادم الخلفية. ولكن العمل الذي تحدثني إليه بشكل أعمق، وهو العمل الذي وقفت أمامه شعرت بالمواجهة والدهشة، كانت “شروق الشمس” لمونيكا دي ميراندا، صورة فوتوغرافية مكونة من ثلاث لوحات لثلاثة أشخاص سود خاصراتهم لبحر شاسع، يقفون في الماء حتى ركب الساق. خلفهم، يمتد أفق بأسعد من منحنى الأرض، وموجة تتسارع نحوهم، غير مرئية. لديهم تعابير حيادية، ليست سعيدة ولا حزينة، وليست براحة ولا غير مريحة، إنهم مجرد حاضرون. ولكن كل ما يعنى في الصورة هو واضح. أزمة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، سفينة امبر ويندروش، عبودية العبيد الأطلسيين، أرواح الأمة السوداء التي أُلقيت فوق المتن. وربما أيضًا، الأساطير الأفريقية للمستقبل كدركسيا وآلهة المياه اليوروبية أوشون، وأويا ويموجا. واقفًا في الجاليري، كان هنالك كما لو أن كل هؤلاء الناس والأرواح والكائنات عالمية الأخرى يدعونني لشهادة. ونظرًا لهم، بدأت أرى نفسي في المشهد، أيضًا. “روحية المشاهد” في جاليري فندلويتش حتى 2 يونيو. تابع @FTMag للحصول على أحدث قصصنا أولاً واشترك في بودكاست Life and Art أينما تستمع منه.