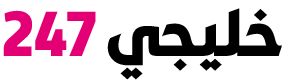في مثل هذا اليوم من شوال، قبل 10 أعوام، انطفأ في باريس ضوء الزميل العزيز سعود الدوسري، لكن شعاعه حتى اليوم لم ينحسر. أغمض عينيه بهدوء يشبه حضوره، ورحل عنا كما عاش بيننا: أنيقًا، نبيلًا، بلا ضجيج.
لم يكن مجرد وجه جميل يطل من الشاشة، بل كان إنسانًا يحمل رهافة الداخل، وحضورًا يعكس ذوقًا نادرًا، لا يُصطنع.
الدوسري، القادم من الدلم، لم يكن سهل التعريف أو التصنيف، ففي وجهه سكينة، وفي صوته اتزان، وفي حرفه لمسة شاعر لا يقول كل شيء لكنه يوصل كل شعور. من إذاعة القرآن الكريم، إلى إذاعة الرياض، ثم إلى أثير MBC FM في لندن، بدأ رحلته بتؤدة العارف أن ما يُبنى على الحضور لا يسقط بالغفلة.
كان رحمه الله، من أولئك الذين لا يحتلون الشاشة، بل يسكنونها كما يسكن الهدوء الأماكن الرحبة.
تسلل إلى القلوب لا بصخب، بل بنبرة صادقة، وبأسئلة تعرف إلى أين تتجه. عرفته في «ليلة خميس» بصحبة صديقه أحمد الحامد.
تألق في «نقطة تحول»، ولامس الأرواح في «ليطمئن قلبي»، وبث الحنين في «جار القمر» و«حنين»، فكانت برامجه صورة منه: أنيقة، راقية، لا تُشبه إلا نفسها.
في كواليس العمل، كان سعوديًّا خالصًا في ودّه، متجردًا من المناصب، كريم المعشر، واسع الصدر، لا يترك مجلسًا دون أن يملأه دفئًا.
صداقاته لم تكن عابرة، بل ممتدة كظلال النخل، تظلل وتمنح. وحين يسكن بيروت أو الرياض أو باريس، يسكن معه كل من عرفه، لأن سعود لم يكن عابرًا في أحد.
نال جوائز مرموقة، كأفضل مذيع عربي 1995، و«جوردن أووردز» 2010، لكنها لم تكن تكريمه الأهم؛ لأن تكريمه الأصدق كان في محبة الناس، في دمعة زميل، في دعاء مشاهد، وفي ذكرى تتجدد كل عام.
مات الدوسري، لكنه أبقى لنا الهدوء الذي عاش به، والقيمة التي مثّلها، والذوق الذي افتقدناه كثيرًا في زحام المشهد.
هو ليس فقط ما كان عليه، بل ما كان يزرعه فينا: إن الإعلام يمكن أن يكون مهذّبًا، راقيًا، وإن الحضور لا يصنعه الصخب، بل الإنسان.
أخبار ذات صلة